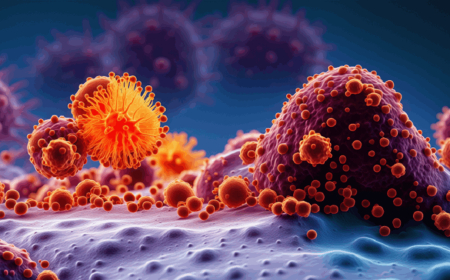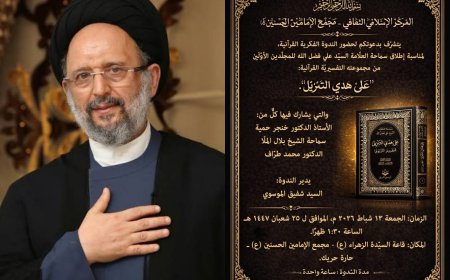كيف تصنع الشاشة طفلًا لا يشبه الواقع؟ ما لا تقوله فيديوهات الأطفال عن ثمن السعادة !
تحقيق مجتمعي يكشف أن المحتوى الطفولي لم يعد مجرّد ترفيه، بل أداة تؤثر في وعي الأطفال، تصوّر السعادة كرفاه دائم، وتفرض ضغوطًا نفسية خفية على الطفل والأسرة في عصر الشاشة.

تحقيق :هناء بلال
لم تعد الطفولة اليوم مساحة عفوية للّعب والاكتشاف، بل باتت، في كثير من الحالات، مشهدًا مُعدًّا بعناية خلف عدسة كاميرا! بين ملايين المشاهدات ومقاطع الفيديو القصيرة، يقف الأطفال في موقعين متقابلين ظاهريًا، متشابهين أثرًا:
أطفال يُستَخدمون كصُنّاع محتوى، وآخرون يستهلكون هذا المحتوى بشغف. وفي الحالتين، تُعاد صياغة مفهوم الطفولة والسعادة عبر نموذج واحد: الرفاه المبالغ فيه.
الطفل صانع المحتوى… رفاه مُكلِف
يظهر الطفل أمام الكاميرا محاطًا بعالم مثالي فيه هدايا لا تنتهي، ملابس من علامات فاخرة، منازل فخمة، رحلات مستمرة واحتفالات مُبهرة لكن خلف هذا المشهد المصقول، تختفي أسئلة لا تُطرح غالبًا:متى يكون هذا الطفل طفلًا فقط؟ ومتى يصبح مؤدّيًا؟
الطفل المتابع… توقّعات أكبر من الواقع
في الجهة الأخرى، يشاهد ملايين الأطفال هذا المحتوى دون أدوات نقدية أو وعي إعلامي.
ما يُعرض لا يُقدَّم كحالة استثنائية، بل كـ«حياة طبيعية»، فيبدأ الطفل بمقارنة واقعه بما يراه على الشاشة.
هاتف أحدث، ملابس أغلى، غرف نوم تشبه الاحلام سفر متكرر، واحتفالات تشبه تلك التي يشاهدها يوميًا. وعندما تعجز الأسرة عن تلبية هذه التوقّعات، لا يفهم الطفل الفروق الاقتصادية أو الاجتماعية، بل يختبر شعورًا بالحرمان أو الغضب أو الإحباط.
ضغط غير مرئي على أهالي الأطفال المتابعين
لا يتوقف أثر المحتوى المليء بالرفاه عند الطفل المتابع وحده، بل يمتدّ بثقله إلى الأهل، الذين يجد كثيرون منهم أنفسهم في مواجهة يومية مع توقّعات تفوق إمكاناتهم الواقعية. فالصورة التي يراها الطفل على الشاشة لا تظلّ حبيسة العالم الرقمي، بل تنتقل إلى داخل البيت، وتتحوّل إلى مطالب متكرّرة ومقارنات صامتة أو معلنة.
أهلٌ يعملون بجهد لتأمين حياة مستقرة لأطفالهم، يصطدمون بأسئلة من نوع:
لماذا لا نملك هذه اللعبة؟ لماذا لا نسافر مثلهم؟ لماذا لا نخرج في نزهة كل أسبوع؟
أسئلة لا تنبع من حاجة حقيقية، بل من صورة مُكرَّسة تُقدَّم على أنها «المعيار الطبيعي» للطفولة السعيدة.
هذا الواقع يولّد لدى كثير من الأهل شعورًا بالعجز أو التقصير، حتى وإن كانوا يوفّرون لأطفالهم ما يكفيهم من رعاية وأمان. بعضهم يشعر بالذنب لعدم قدرته على مجاراة نمط حياة استعراضي، وبعضهم الآخر يدخل في دائرة ضغط مادي ونفسي، محاولًا تعويض الفارق عبر إنفاق يفوق قدرته، أو تقديم وعود يصعب تحقيقها.
بهذا المعنى، لا يكون الأهل مجرد متفرّجين عاجزين، بل أطرافًا متأثّرين مباشرة بمنظومة رقمية تفرض نموذجًا واحدًا للطفولة، نموذجًا لا يراعي الفروق الاجتماعية ولا الظروف الاقتصادية، ويحوّل الحياة اليومية إلى مقارنة مستمرة، تُرهق الأسرة وتشوّه الإحساس الحقيقي بالرضا والاكتفاء.
للاجابة عن هذه الاسئلة كان لنا لقاء مع المستشارةة في الصحة النفسية والعلاقات الأسرية ريان هاشم التي أجابت على الاسئلة التالية :
ما الفرق بين الترفيه البصري الآمن والمحتوى الذي قد يؤثر نفسيًا على الطفل؟
ليس كل ما يضحك الطفل أو يجذبه بصريًا يُعدّ آمنًا نفسيًا. فالمحتوى الطفولي اليوم لم يعد مجرّد وسيلة ترفيه، بل أصبح أداة قوية تُسهم في تشكيل وعي الطفل، نظرته للحياة، وتوقعاته من ذاته ومن محيطه.
أين تكمن الخطورة الحقيقية في المحتوى الطفولي؟
الخطورة لا تكمن في المشاهدة بحد ذاتها، بل في نوع الرسائل المتكررة التي تُقدَّم للطفل وتُرسَّخ في الوعي على أنها النموذج الطبيعي للحياة.
ما طبيعة الرسائل النفسية غير المباشرة التي يحملها هذا النوع من المحتوى؟
على الرغم من أن هذا المحتوى يُقدَّم غالبًا ضمن إطار ترفيهي أو تعليمي ظاهري، إلا أن كثيرًا منه يحمل رسائل نفسية غير مباشرة تُزرع في وعي الطفل عبر التكرار، إذ يتم تصوير السعادة بوصفها حالة دائمة مرتبطة بامتلاك الأشياء، وتُعرض الرفاهية المادية كجزء طبيعي من الحياة اليومية، كما تُقدَّم العلاقات الأسرية بصورة مثالية تخلو من الصراع أو النقص، ما يجعل الطفل يبني تصورًا غير واقعي عن طبيعة الحياة الإنسانية.
كيف يتفاعل دماغ الطفل عصبيًا مع هذا النوع من المحتوى؟
من الناحية العصبية، يتعامل دماغ الطفل مع هذا النوع من المحتوى بدرجة عالية من القابلية للتأثر، نظرًا لمرونته العصبية المرتفعة، حيث تؤدي الألوان القوية، الإيقاع السريع، وتسلسل الأحداث المليئة بالمكافآت الفورية إلى تحفيز نظام الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمتعة والتحفيز، ومع تكرار هذا التحفيز يتعلّم الدماغ ربط الإحساس بالسعادة بالإثارة السريعة والمثير الخارجي، بدلًا من ربطه بالجهد، الانتظار، أو الإنجاز التدريجي.
ما الانعكاسات السلوكية والنفسية لهذه الأنماط العصبية على الطفل؟
مع مرور الوقت، تبدأ هذه الأنماط العصبية في الانعكاس على السلوك النفسي للطفل، فينشأ لديه توقّع داخلي بأن الرغبات يجب أن تُلبّى فورًا، وأن الإحباط أو التأجيل حالة غير مقبولة، ما يؤدي إلى ضعف قدرته على تحمّل الملل، وقلة مرونته في مواجهة الواقع اليومي الذي لا يشبه ما اعتاده على الشاشة، الأمر الذي يخلق فجوة نفسية بين عالمه الداخلي والواقع الخارجي.
متى تظهر آثار هذا المحتوى بشكل أوضح؟
تظهر آثار هذا المحتوى بشكل أوضح عند الأطفال الذين يتعرّضون لنماذج متكررة من البرامج التي تركز على الرفاهية المفرطة، مثل تلك التي تُظهر بيوتًا كبيرة، ألعابًا متوفّرة بلا حدود، واستجابة دائمة لكل رغبة، حيث تُرسَّخ في وعي الطفل فكرة أن هذا الشكل من الحياة هو المعيار الطبيعي، وأن أي واقع مختلف يُعدّ نقصًا أو حرمانًا غير مبرر.
كيف يؤثر ذلك على مفهوم الذات لدى الطفل؟
هذا التشكّل المعرفي والانفعالي ينعكس مباشرة على مفهوم الذات لدى الطفل، إذ قد يبدأ بربط قيمته الشخصية بما يمتلكه من أشياء لا بما هو عليه كإنسان، ويصبح أكثر حساسية تجاه الرفض، وأكثر عرضة لنوبات الغضب عند عدم تلبية رغباته، فضلًا عن صعوبة تنظيم مشاعره والتعامل مع الإحباط، نظرًا لاعتماده النفسي المتزايد على مصادر خارجية للشعور بالأمان والرضا.
ما التأثيرات المحتملة على المدى البعيد؟
على المدى البعيد، يمكن أن تمتد هذه التأثيرات لتشمل ضعف القدرة على الصبر، زيادة الاعتماد النفسي على المثيرات السريعة، تشوّه التوقعات تجاه العلاقات الأسرية والاجتماعية، وصعوبة بناء علاقات متوازنة قائمة على التفاهم والحدود، ما يجعل الطفل، حين يكبر، أقل استعدادًا للتعامل مع تعقيدات الحياة الواقعية.
كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية تربويًا؟
في الختام، لا تكمن المشكلة في وجود المحتوى الطفولي بحد ذاته، بل في التعرّض غير الواعي والمتكرر له دون مرافقة أو تفسير، فالطفل لا يملك بعد القدرة على التمييز بين الخيال والواقع، وكل ما يتكرّر أمامه يتحوّل تدريجيًا إلى قاعدة نفسية يُبنى عليها فهمه للحياة، الأمر الذي يجعل الوعي الأسري والتربوي عنصرًا أساسيًا في حماية التوازن النفسي للطفل، ليس عبر المنع المطلق، بل من خلال التفسير، التوازن، وإعادة ربط السعادة بالقيم الداخلية.