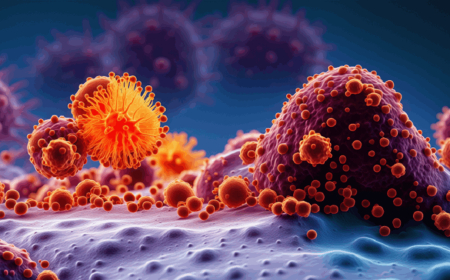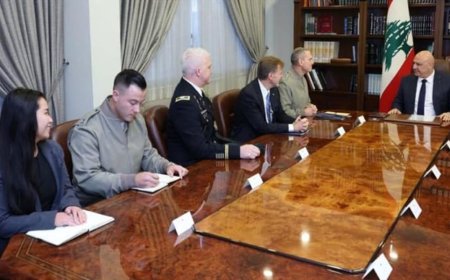من الشرعية إلى الفتنة: كيف تحوّل الانقسام السني–الشيعي إلى ثغرة وجودية في المشرق الوسيط

كتب باسم الموسوي:
في التاريخ الوسيط للمشرق العربي الإسلامي، لا يمكن فهم الانقسام السني–الشيعي بوصفه خلافًا عقديًا صرفًا أو نزاعًا فقهيًا بين مدارس دينية، بل بوصفه مسارًا تاريخيًا متحوّلًا بدأ صراعًا على الشرعية السياسية، ثم انزلق تدريجيًا إلى فتنة مذهبية اجتماعية، قبل أن يتحول، في لحظة الانكشاف الكبرى، إلى ثغرة استراتيجية قاتلة في بنية الكيان الإسلامي. ولم يُتجاوز هذا الانقسام إلا عندما فُرضت، قسرًا أو وعيًا، أولوية الوجود على أولوية المذهب، أي حين صار البقاء ذاته مهددًا.
الشرعية: أصل الانقسام
نشأ الانقسام في جوهره حول سؤال الحكم: من يملك الحق في السلطة بعد النبي؟ لم يكن السؤال سؤال عقيدة بقدر ما كان سؤال مشروعية سياسية. الخلافة العباسية، بوصفها تعبيرًا عن منطق الشورى والبيعة، مثّلت تصورًا سنيًا للسلطة يستند إلى الجماعة وإجماعها. في المقابل، قدّمت الخلافة الفاطمية تصورًا مغايرًا جذريًا، قائمًا على الإمامة الوراثية والوصية الإلهية، حيث تصبح السلطة امتدادًا للنسب، ويغدو الإمام حاملًا لشرعية دينية وسياسية معًا.
بهذا المعنى، لم يكن الانقسام في بدايته صراعًا بين “سنة” و“شيعة” بالمعنى الاجتماعي الواسع، بل نزاعًا بين نموذجين للسيادة: سيادة الجماعة مقابل سيادة النص والنسب. وقد تعايش هذان النموذجان زمنًا طويلًا في فضاء واحد دون أن يتحولا بالضرورة إلى حرب أهلية شاملة.
من السياسة إلى الفتنة
غير أن السياسة، حين تفشل في الحسم، تستدعي التعبئة. ومع الوقت، تحوّل النزاع على الشرعية إلى استقطاب مذهبي، لا لأن العقائد تغيّرت، بل لأن المذهب صار أداة للتجييش والتعبئة وإعادة إنتاج الولاء. بغداد والقاهرة، مركزا الخلافتين، تحوّلتا إلى قطبين متقابلين، وبينهما بلاد الشام، التي صارت ساحة صراع دائم، لا بسبب موقعها الجغرافي فحسب، بل لأنها كانت مرآة الانقسام السياسي نفسه.
هنا تبدأ الفتنة: ليس لأن الناس اختلفوا فجأة في الإيمان، بل لأن السلطة احتاجت إلى تحويل الخلاف السياسي إلى هوية جمعية. صار الانتماء المذهبي علامة ولاء سياسي، وتحول الخلاف النظري إلى عنف اجتماعي، واندلعت اضطرابات، وعمّ الشك، وتفككت الروابط الجامعة. في هذه اللحظة، لم يعد المذهب تعبيرًا عن قناعة دينية، بل صار لغة للصراع.
الانقسام كثغرة استراتيجية
لكن الخطر الحقيقي لم يتجلى في الفتنة ذاتها، بل في ما فتحته من أبواب. حين دخلت القوى الصليبية إلى المشرق، لم تدخل أرضًا موحّدة تواجه خطرًا خارجيًا، بل فضاءً ممزقًا بين سلطتين متنافستين، كل منهما ترى في الأخرى خصمًا أول، وأحيانًا أخطر من الغريب القادم من وراء البحر.
الانقسام السني–الشيعي، وقد صار سياسيًا ومذهبيًا في آن، تحوّل إلى ثغرة استراتيجية. كل طرف راهن، ولو ضمنيًا، على أن هزيمة الطرف الآخر قد تكون مكسبًا، حتى لو جاءت على يد قوة خارجية. هكذا أُضعفت فكرة الجبهة المشتركة، وتآكل معنى “العدو الخارجي”، وصار الصراع الداخلي يسبق مواجهة الخطر الوجودي.
لم يكن الغزاة بحاجة إلى قوة خارقة بقدر حاجتهم إلى فراغ داخلي، وقد وُجد هذا الفراغ حين انقسمت الشرعية، وتقدّم المذهب على الدولة، والطائفة على المجال العام.
أولوية الوجود: لحظة التجاوز
لم يبدأ تجاوز هذا الانقسام إلا عندما وصلت الكيانات السياسية إلى حافة الزوال. عند هذه النقطة، لم يعد السؤال: من الأحق بالحكم؟ بل: هل سيبقى الحكم أصلًا؟ هنا فقط فُرضت أولوية جديدة، لا تقوم على نفي الاختلاف، بل على تعليقه مؤقتًا. لم تُحلّ المسألة المذهبية نظريًا، لكنها فقدت قدرتها على الهيمنة.
حين فُرض منطق الوحدة السياسية والعسكرية لمواجهة الخطر الوجودي، تراجع المذهب من كونه أداة صراع إلى كونه مكوّنًا اجتماعيًا ضمن كيان أوسع. لم يكن هذا التحول نتاج مصالحة فكرية، بل ثمرة إدراك عملي بأن الانقسام الداخلي، مهما بدا مبررًا أو “مقدسًا”، يصبح انتحارًا حين يهدد الوجود ذاته.
خاتمة
يُظهر تاريخ العصر الوسيط أن الانقسام السني–الشيعي لم يكن قدرًا لاهوتيًا ولا حتمية دينية، بل مسارًا سياسيًا تحوّل بفعل السلطة، ثم انفلت بفعل الفتنة، وانكشف كليًا حين واجه اختبار البقاء. وما لم يُتجاوز هذا الانقسام إلا عندما فُرضت أولوية الوجود على أولوية المذهب.
في هذا الدرس التاريخي تكمن مفارقة قاسية: لا تنتصر الجماعات حين تتشبث بشرعياتها الخاصة، بل حين تعيد تعريف الشرعية نفسها بوصفها شرطًا للبقاء المشترك. حينها فقط، يتحول التاريخ من سجل للانقسام إلى مختبر لإمكانيات النجاة.