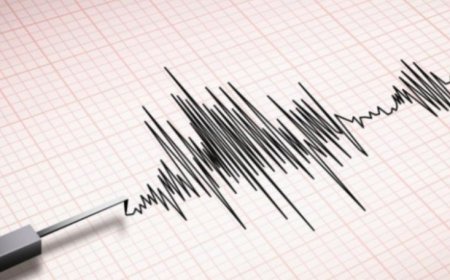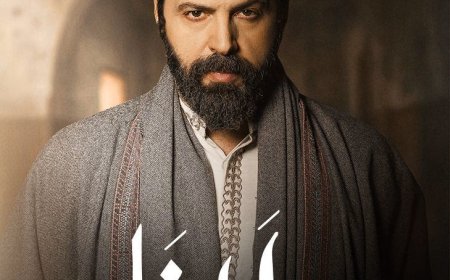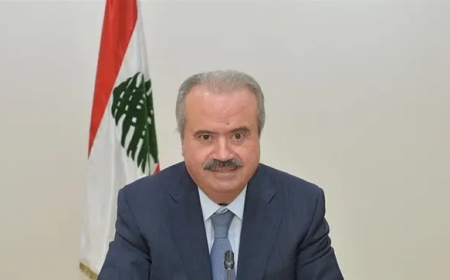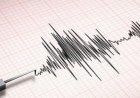الروائي عبد الحليم حمود: المنبر الثقافي اليوم لا يقدّم الحقيقة… بل يصنع أثرًا داخل الفوضى
حوار فكري مع الناقد والكاتب اللبناني عبد الحليم حمود حول تحوّل المنابر الثقافية من الورق إلى الفضاء الرقمي، وسؤال التأثير والشرعية الرمزية، ودور الثقافة اليوم في صناعة المعنى داخل زمن السرعة والفوضى المعرفية.

حوار: هناء بلال
في عالم تتغيّر فيه أولويات الناس بوتيرة متسارعة، وتتصارع المنصّات سواء تلك التي تنشر في الصحف الورقية أو عبر المواقع الإلكترونية على انتزاع لحظة انتباه عابرة، تظلّ المنابر الثقافية مساحة مختلفة تمامًا. فهي لا تُعنى بالضجيج ولا تركض خلف الاستهلاك السريع، بل تعمل على ترتيب الفوضى وتحويلها إلى معنى. هنا تُقرأ الكلمة لا لتُستهلك، بل لتفتح نافذة على وعي جديد، ولتطرح الأسئلة التي تخشى مؤسسات كثيرة الاقتراب منها.
عبد الحليم حمود كاتب وناقد و روائي لبناني معاصر، يُعرف بأسلوبه التحليلي العميق وكتاباته التي تمزج بين الأدب والفلسفة والهوية. قدّم مساهمات لافتة في المشهد الثقافي العربي، وبرز في مجالات النقد الأدبي، السرد، وقراءة التحولات الاجتماعية والسياسية من منظور فكري.
يتميّز حمود بلغته الرشيقة التي تحمل بعدًا تأمليًا، وبقدرته على تفكيك النصوص والظواهر بطريقة تجمع بين العمق والبساطة، ما جعله صوتًا حاضرًا في الصحافة الثقافية والحوارات الفكرية.
في هذا اللقاء، نقترب من هذه المنابر باعتبارها نبضًا فكريًا حيًا، ومرآة تعكس تحوّلات المجتمع، وتجربة تحاول رغم صعوبة الزمن الرقمي أن تحافظ على علاقة صادقة بين القارئ والمشهد الثقافي. نسأل عن أثرها الحقيقي اليوم: هل ما زالت قادرة على التأثير وصناعة الذائقة؟ وهل استطاعت أن توصل رسالتها في ظل التسارع الإعلامي وحضور المحتوى الخفيف والطاغي؟
المحور الأول: تحوّل المشهد الثقافي وتبدّل مركز السلطة
•كيف تقيّمون الدور الحقيقي للمنابر الثقافية اليوم؟ وهل ما زالت تمتلك القدرة على تشكيل الذائقة العامة كما في السابق؟
ـ المشهد الثقافي القديم كان يشبه جسدًا يعرف أعضاءه جيدًا: كتاب يفتح بوابة، مجلة تضبط اللغة، برنامج ثقافي يرفع الأسماء، صالة عرض تمنح الصورة جلالها، ومركز ندوات يكرّس النقاش. عناصر تسير في خط واحد، يصنع كل منها معنى ثابتًا ويعطي الآخر موقعه، فتتشكل سلطة ناعمة تنظم الحركة وتمنح الشرعية.
اليوم يتسع المشهد إلى فضاء أشبه بتداول دائم للكيانات، حيث يذوب المركز ويتحوّل كل عنصر إلى عقدة داخل شبكة واسعة. الانترنت، المنصات الرقمية، الجامعات التي تعيد إنتاج المعارف بطرائق جديدة، والشركات التكنولوجية التي تمسك بمصادر البث والمعرفة، جميعها تصنع انفجارًا هائلًا يبتلع تلك البنية القديمة ويعيد توزيع أدوارها.
لم يعد الكتاب يقف على الرف منتظرًا قارئًا واحدًا؛ يتحرك عبر موجات متتالية من إعادة التوليد: مقطع يُقتطع منه على منصة، صورة تُحمّل مع اقتباس، مراجعة صوتية تتردد في أذن عابرة، نقاش حيّ في بث مباشر. مع كل انتقال يتكوّن معنى مختلف، ومع كل معنى تتسع المسافة بين ما يُكتب وما يُقرأ، فيصير النص نفسه كائنًا يهاجر بين القوالب ويغيّر جلده.
المجلة لم تعد المركز الذي يسمع الناس عبره ضجيج الثقافة. تتحول إلى عنصر ضمن طوفان المحتوى، تُسهم في صناعة حركة أوسع تتحكم فيها خوارزميات تقيس التفاعل وتعيد ترتيب الظهور. حتى البرنامج الثقافي الذي كان يقف فوق خشبة ثابتة، يدخل اليوم في منطق المقاطع القصيرة، فينكمش زمنه ويتشظى صوته، ويحضر بقدر ما يلتقط الجمهور منه شرارة عابرة.
وصالة العرض التشكيلية، التي كانت حجارة المعنى تتجمع فيها بوقار، تتحول إلى صورة تنتشر بسرعة، ثم تُعاد صياغتها في ذاكرة بصرية رقمية لا تعرف الإقامة. العمل الفني يفقد صمته القديم، ويكتسب صدى جديدًا يأتيه من بصمات المشاهدين ومن فوضى الظهور اللحظي.
أما الجامعة فتنفتح على عالم يتقاطع فيه البحث الأكاديمي مع المحتوى المفتوح، ومع مراكز البيانات، ومع الشركات التي تصنع بنية تحتية معرفية تمتد فوق الأرض كلها. المعرفة تفقد حدودها الحديدية، فتدخل في حركة أوسع، تُدار فيها المفاهيم بطرائق هجينة يتقاطع فيها العمق مع السرعة.
بهذا المعنى، يتكوّن المشهد الثقافي الجديد من طبقات متراكبة تتحرك بلا محور واحد. هناك لعب دائم في توزيع السلطة بين النص، والمنصة، والقارئ، والاقتصاد الذي يمسك بالبث. كل شيء يتحرك داخل سلسلة لا تتوقف من الإحالات: الكتاب يستدعي هاشتاغًا، الهاشتاغ يستدعي فيديو، الفيديو يستدعي نقاشًا، والنقاش يستدعي بحثًا جديدًا.
المحور الثاني: المنبر الثقافي بين الحاجة المعرفية والترف
•برأيكم، هل يقرأ الجمهور اليوم المنبر الثقافي بوصفه حاجة معرفية، أم بوصفه ترفًا يمكن الاستغناء عنه؟
ـ المقولات حول المنبر الثقافي تفتح أمامنا خريطة للسلطة والرمزية. ثمة منابر باقية تمسك بسلطة متجاوزة للجمْع بين المطبوع والعرض، بين الفكر والجسد، بين ما يُقال وما يُعرض. إنها منابر تنتزع لنفسها «مقامًا» خاصًا، موقعًا ضمن الحقل الثقافي يضفي على بعضها ثقلًا، عبر ما تمتلكه من تاريخِ تأسيس ونشرٍ، ومن حضورٍ مؤسّسي، ومن قدرةٍ على الالتقاط والتقديم.
حينما تخرج صحيفة، مجلة، كتاب، برنامج ثقافي، مؤتمرًا أدبيًّا أو فعالية معمارية للوحة صادمة، فإنها تعبّر عن ما يمكن تسميته «سُلطة التشكيل». هذه السُلطة ليست مطلقة، تحافظ على شروطها: جهد إعداد، اختيار، تأني، تنقيح، انضباط في العرض. في ظل انفجار الخطاب الرقمي، تحتفظ هذه المنابر بخصوصيتها: رمزية تجعلها محطة للتمييز، عبارة عن مكان يتم فيه «تشكيل» المعرفة والعلامة في شكل يختلف عن التدفق المضطرب للشبكة.
الدور الذي تؤديه هذه المنابر يظل فعلًا تنظيميًّا: هي مرجعية بالمعنى البسيط المعقَّد: تُنجز معنى يُنشر، تُقدّم إطارًا للتلقي، تخلق فنًا قابلًا للسؤال، نقدًا قابلًا للمساءلة، حوارًا قابلًا للاستمرار. حضورها يدل على أن الفضاء الثقافي لم ينسل بخفة في يد السوق والخوارزميات وحدها، إنما لا يكمن له أيضا أن يدّعي القوة التي كانت له حينما كان يبني المنظومة بنفسه.
التواضع في الطموح، الاعتراف بالحدود، إدراك مدى التأثير الحقيقي: هذه صفة جوهرية لمنبر ثقافي فعّال اليوم. هو لا يدّعي أن يغيّر العالم وحده، إنما يدعوه بأن يبدأ في زاوية، يفتح بابًا، يضع نصًّا، يعرض لوحة، يطلق فكرة. في هذه الزاوية الصغيرة، يمكن أن يولد عمق، تشظٍّ فكري، سؤال يقطع طريقًا داخل عراء الفوضى المعرفية.
المحور الثالث: الرسالة وإشكالية المفهوم
•ما الرسالة التي أرادت المنابر الثقافية إيصالها عند تأسيسها؟ وإلى أي مدى تشعرون أنها لا تزال أمينة لهذه الرسالة؟
ـ أتحفظ على كلمة رسالة وتحفظي يأتي من شعور بأن هذا المفهوم ينتمي إلى زمن كانت فيه المعرفة تصعد من نقطة واحدة لتنهمر على الجمهور. كلمة تحمل إيقاع الوعظ، ومسارًا رأسيًا، ومركزًا يوزّع الحقيقة. بينما الواقع الحالي يتحرك عبر تدفقات أفقية، سرعة فائقة، وتشظٍّ يجعل كل قارئ قادرًا على الوصول إلى المعلومة قبل أن تصل إليه عبر أي منبر.
لم يعد العالم ينتظر منبرًا يقدّم الحقيقة. تتوزع الحقيقة داخل ملايين الشاشات، وتولد من محركات البحث أكثر مما تولد من أي منصة منظمة. لهذا يبدو المنبر الثقافي اليوم كيانًا لا ينطق من فوق، بل يتحرك داخل اللعبة ذاتها، في قلب المحاكاة المتواصلة بين الورقي والرقمي، بين الظهور والتلاشي، بين الأصل والصورة التي تحلّ محل الأصل.
حين تطبع مجلة «البعد الخامس» على الورق، ثم تنشر المادة ذاتها على الموقع الإلكتروني وعلى منصة فيسبوك، فإنها تدخل في منطق مضاعفة المعنى الذي ينسج العالم الحديث: النص الواحد يعيش في فضاءات متعددة، يغيّر هويته في كل بيئة، يتحول من ورق يلامس اليد إلى شاشة تُحرّك بالإصبع، من مادة ثابتة إلى حدث سريع العبور.
لا يعود السؤال عمّا إذا كان المنبر يقدّم رسالة، بل عمّا إذا كان يستطيع إنتاج أثر داخل هذا الفراغ المشبع بالصور. الورق يحمل رصانة العالم القديم، والصفحة الإلكترونية تحمل سرعة العالم الجديد، والفيسبوك يقدّم نسخة ثالثة، تنتمي إلى الاقتصاد الرمزي للظهور، حيث يتساوى المقال مع الميم ومع الصورة العابرة.
المنبر الثقافي يظل فاعلًا حين يدرك أن قيمته لا تدخل من باب الوعظ، بل من باب خلق نقطة كثافة داخل بحر من المحاكاة لحظة يلمع فيها نص بوضوح مختلف، أو فكرة تتجاوز التكرار، أو مقاربة تكسر سطح الخطاب اليومي
المحور الرابع: من الورق إلى الضوء
•كيف أثّر انتقال الثقافة من الورق إلى الفضاء الرقمي على مضمون المنابر وعمقها؟
ـ ينفتح العالم الضوئي كمرحلة جدلية ضمن مسيرة الروح التي تنتقل من شكل إلى شكل، فيصير الضوء وسيطاً شاملاً يوسّع دائرة الشريعة الثقافية ويجعل المعلومة والإشكال متاحَين بيسر يفوق كل مطبوعة، مهما امتلأت صفحاتها بالحبر والكلمات. الضوء بهذا يصبح تتويجاً للوسيلة الطباعة، وتعبيراً جديداً عن الروح العالمية التي تشق طريقها عبر البصر، الصوت، الصورة عبر هندسة الفضاء الكوني البصري — لتجمع بين المعرفة والحسّ في لحظة واحدة.
حين يعانق نور الشاشة الفكر، يتحول السؤال إلى حضور حي، والفكرة إلى بُعد بصري وحسي، والرؤية إلى تجربة تنبض بالحركة، بالصوت، بالصورة، بالشاشة. تتلاشى الوحدات المتناثرة المطبوعة وتشرق وحدة مغايرة: وحدة تتجاوز جلود الكتب إلى فضاءات افتراضية تندمج فيها الذائقة مع التشكيلي، السينمائي، الهندسي. 
بهذه البنية الجديدة يتجسد ما يشبه سياسة روح العصر، حيث الحسّ والمعرفة يتشابكان في جدلية تكسر حدود الشكل الكلاسيكي.
جيل أحب رائحة الحبر، ملمس الورق، التزام الانصات الساكت. هذا الجيل يشعر بخسارة تكتسب طابعاً وجودياً: ليس فقدان مادة فقط، بل فقدان رؤية متجمّدة تنقل المعنى بثقل ووقار. هذه الحنين ينبع من إجماع على شكل معيّن للثقافة، شكل اعتاد أن يحمل الوزن الرمزي والعمق.
مع ذلك، الفعل الثقافي لا يستقرّ على شكل واحد. العالم الضوئي من دون أن يُلغي القديم، يُضيف بعداً جديداً لوعي الروح. فيه تتحول الثقافة إلى عملية تحليل داخلي وتجربة عالمية تجمع بين الصوت والصورة والفكر والحركة. الروح، بوساطة هذا الضوء، تتجاوز الشوق إلى الماضي، فتخلق حضوراً جديداً: حضور يتكوّن من انصهار الرؤية بالمعنى، من تكوين جديد للوعاء الثقافي، من لحظة فكرية-حسية تضع الجيل القديم والجيل الجديد في تلاقٍ غير تقليدي.
ـ يشبه المشهد الراهن طاولة عظيمة تتكدّس فوقها الأطباق كلّها، في آن واحد، دون فصل بين المالح والحلو، بين الصارم والناعم. السوق انفجر بحواسّه، وبات يقدّم كل معرفة كما لو أنّها طبق جاهز يطلبه المتلقي بضغطة واحدة. هذه الوفرة تمنح العالم إيقاعًا جديدًا، إيقاعًا يقوم على وفرة العلامات وتكاثرها، حيث تتحرك اللغة داخل تدفّق مستمر، وتتحوّل الفكرة إلى أثر سريع العبور، يدخل العين والفم واليد في اللحظة نفسها.
في هذا الامتلاء تصبح الحاجة إلى التبسيط أشبه بآلية بقاء. التكثيف يتحوّل إلى طريقة في السرد، في العرض، في التفكير. المعارف تتداخل: الفن يتسلل إلى الفلسفة، الفلسفة تلتقي الصحافة، الصحافة تقترب من السرد، والسرد يتشرب من الصورة.
ميدان يعانق الآخر بشيء من الخفة، فيولد معنى جديد داخل منطقة تماسّ تتخلى عن الطقوس الثقيلة.
التجربة البصرية تتقدم هنا كقوة صامتة، تلتقط الأشياء وتحوّلها إلى رموز فورية. القارئ والمشاهد والمستمع يتحركون داخل عالم يُعاد صياغته وفق سرعة العين ولذة الالتقاط. كل نص يصبح صورة، والصورة تصبح ومضة، والومضة تتحول إلى شيفرة صغيرة تكفي لإشباع فضول سريع.
بهذا المعنى، الاختزال ليس ضعفًا، بل أسلوبًا في التعامل مع فائض العالم. كل فكرة تُقدَّم بجرعة عالية الوضوح، كما لو أنّ النص نفسه يركض ليلحق بوعي متسارع. الكثافة تصبح رغبة في تحرير المعنى من أثقاله، تمنحه قدرة على القفز، على الظهور، على المرور بين الأصابع دون أن يفقد بريقه.
هكذا يتشكل زمننا: زمن علامات متشابكة، زمن اختصارات حيوية، زمن تُعاد فيه المعرفة إلى جوهرها الأول، إلى تلك اللمعة التي تسبق الجملة، إلى ومضة تقول الكثير بمجرد أن تصل إلى العين.
المحور الخامس: التأثير والشرعية الرمزية
•هل تعتقدون أن هذا التأثير ما زال ملموسًا في وعي القارئ وسلوك المجتمع؟
ـ حين نتأمل حضور المؤسسة الثقافية اليوم، تظهر بصورة كيان يواصل إنتاج أثره عبر آلية رمزية أكثر منها معرفية. هناك تأثير بنسبة معينة يعمل في العمق، تغذّيه طبقات من الإرث التاريخي الذي تراكم فوق عناوين وصحف ومجلات وجامعات ودور نشر. هذا الإرث يمنح المؤسسة مكانة تُشبه «صوتًا داخليًا» يرافق أي تفكير أو بحث أو دراسة، كأنها الخلفية التي تشرّع القول وتمنحه صلابة معنوية.
كل التأثير لا يأتي من سلطة مادية، بل من تلك القيمة المتخيلة التي ترمز إليها المؤسسة. وجودها يقدّم ضمانًا غير مرئي: حين ينتشر نص عبرها يشعر القارئ بأنه جزء من سلسلة طويلة من المعنى، سلسلة تربط الحاضر بما قبله. هذا الارتباط لا يعمل بنبرة قطيعة، بل بنبرة استمرارية. العالم الحديث، مهما بدا متحررًا وسريعًا، يظل محتاجًا
إلى مرساة رمزية؛ إلى شيء يُشعره بأن الفكرة ليست مجرّد صوت في فراغ، بل حلقة ضمن تاريخ من التراكمات.
لذلك تبرز ظاهرة «تفخيم الماضي» بوصفها أسلوبًا يعيد تشكيل المكانة الثقافية. حين يقف الفرد أمام نص جديد، يستدعي داخله الماضي الذي يمنحه شرعية إضافية. في هذا الاستدعاء تولد علاقة تشبه تواطؤًا بين القديم والجديد، حيث الماضي لا يُلغى ولا يُبتلع، بل يتحول إلى غلاف يمنح المعنى بريقًا وصدقًا وشكلًا من الثقل الرمزي.
بهذه الطريقة يصبح كل أثر ثقافي اليوم كتاب، عرض، مقالة أو دراسة — مؤطّرًا بما يشبه «هالة خفية» تصنعها ذاكرة المؤسسة. بل يمكن القول إن هذه الهالة تعمل كجزء من اللعبة المعرفية: من دونها تبدو الكثير من المنتجات الثقافية مجرد ضوضاء، ومعها تكتسب موقعًا، حتى لو كان مؤقتًا أو هشًا.
هكذا يستمر تأثير المؤسسة الثقافية. ليس عبر سلطة شمولية، بل عبر حراسة رمزية تتيح لكل نص جديد أن يدخل في سلالة من الاعتراف، وتتيح للمتلقي أن يشعر بأن ما يقرؤه ينتمي إلى شيء أعمق وأوسع من تدفق الشاشة. هذه «الشرعية» هي ما يسمح للحاضر أن يظهر وكأنه امتدادٌ لمعنى أكبر، معنى يطلّ من الماضي ويواصل إغراءه حتى داخل أكثر الأزمنة توترًا وتغيّرًا.
المحور السادس: مستقبل المنابر الثقافية
•هل ما زالت المنابر الثقافية قادرة على طرح الأسئلة المزعجة التي تعبّر عن نبض المجتمع، أم أصبح سقفها محدودًا باعتبارات سياسية وتمويلية؟
ـ يمكن النظر إلى مسألة التمويل الثقافي بوصفها لحظة تجلٍّ لعلاقة معقدة بين المعرفة والسلطة والشرعية. ليس التمويل هنا قيدًا يحدّ المنبر أو ينتقص من قيمته، بل عنصرًا من عناصر بنيته. المنبر، أيًّا كان شكله، يحتاج إلى بيئة حاضنة تمنحه القدرة على إنتاج أثر مستمر، وحضور يليق بما يطرحه من فكر وفن وتحليل. التمويل يتحول في هذا الإطار إلى شرط حياة، لا إلى علامة انتقاص.
حين نذكر مجلات كبرى مثل «العربي» أو «الدوحة»، ندخل منطقة يُظهر فيها التمويل دوره الطبيعي: المنبر لا يعيش في فراغ، بل في سياق ثقافي يحتاج إلى استمرارية، وإلى قدرة على التحرير والطباعة والتوزيع ودفع أجور الكتّاب والمحررين. التمويل هنا لا يُلغِي قيمة النص ولا يشوه صوته؛ بل يسمح للنص بالعبور، بالتموضع، وبأن يصل إلى قارئه في زمن تتطلب فيه المعرفة دعمًا ماديًا كي تُرى وتُسمَع.
وفي أوروبا يظهر هذا النموذج بأوضح أشكاله: الدولة تموّل الأفلام الوثائقية، وتدعم الكونسرفاتوار، وتشتري الكتب من مؤلفيها لتوزيعها في المكتبات العامة. التمويل هنا يتخذ شكل «رعاية مدنية» ترى في الثقافة أحد أعمدة المجتمع، وعنصرًا من عناصر الوعي العام. ليست المسألة مسألة تبعية، بل مسألة إدراك بأن الثقافة قوة تحتاج إلى موارد كي تتحرك داخل العالم.
•ما الذي نجحتم في تحقيقه، وما الذي بقي عالقًا أو مؤجّلًا؟
ـ الورق في نظر كثيرين يعني مخاطرة خاسرة، يعني السير فوق أرض لا تهب مالًا ولا وعودًا. ومع ذلك اتجهنا أنا وشريكي شادي منصور نحو خيار يشبه إعلان وجود. أردنا أن نقول: «نحن هنا»، عبر رصانة الشكل، حدة الهوية، انتظام الإصدار، وثبات الإيقاع. هذه العناصر مجتمعة صنعت حضورًا يتجاوز اقتصاد الثقافة إلى جمالها. عام ونصف من حياة المجلة، وأربع سنوات من حياة دار النشر، شكّلت مسارًا تراكم فيه الجهد حتى أصبح كيانًا يفرض مكانه في الحقل العربي.
كل صفحة كانت فعلًا مقصودًا، وكل عدد خطوة داخل مغامرة تعشق الورق وتدرك قيمته الرمزية داخل عالم يتوهّج بالصورة والضوء. الحضور الورقي يزرع ثقة ويمنح القارئ ملمسًا، ويؤكد أن الثقافة تستطيع أن تمشي على قدميها رغم كل العواصف. هكذا تشكّل حول «البعد الخامس» فضول ثقافي، فضول يقرأ التجربة
باعتبارها إصرارًا على أن المجلة تستطيع أن تكون حدثًا، وأن الحبر يستطيع أن يصنع له ضوءًا يوازي ضوء الشاشة.
•في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، كيف تتصورون مستقبل المنابر الثقافية خلال السنوات القادمة؟
ـ أقول بثقة إن المنابر الثقافية تتسع وتتلألأ، وتفتح لنفسها فضاءات يغمرها نبض المعرفة في كل لحظة. العالم اليوم يفيض بالمعرفة كما يفيض النهر بحجارته اللامعة، وكل منصة تتحول إلى نافذة تطلّ على عالم من الأفكار. يكفينا أن نرى حلقات أحمد الغندور، ذلك الجهد الممتلئ بالدهشة والشرح المتقن، أو المواد التحليلية العميقة التي يقدّمها المخبر الاقتصادي، أو السرد التاريخي الذي يصنعه شارل حايك بعدسته الفاحصة، أو المقاربة السياسية التي يقدّمها جاد غصن بحسّ نقدي يقظ.
هذه الأسماء تحوّلت إلى منابر قائمة بذاتها، منابر تحمل روحًا جديدة للعمل الثقافي، وتبثّ المعرفة بطرق مرنة وحيوية. كل منهم يمسك بخيط من خيوط الثقافة ويحوّله إلى مساحة يتقاطع فيها الفكر مع الحكي، والتحليل مع الإمتاع، والصوت مع الصورة. في هذا الامتداد تنضج ثقافة تتغذّى من تعدد الوسائط، وتتحرك بين الشاشة والورق واللقاء المباشر دون حواجز.
المنبر الثقافي اليوم يتجدد مع كل ضوء يظهر على الشاشة، ومع كل صوت يشرح، ويحاور، ويحلل. تزداد المنابر لأن جمهور المعرفة يتسع، ولأن الحاجة إلى الفهم تتنامى. تتألق المنابر لأنها تجري على إيقاع عصر يفتح أبوابه للأفكار كافة، ويمنح كل باحث ومبدع قدرة على أن يضع بصمته في الفضاء العام. هكذا يولد مشهد جديد، مشهد تتشابك فيه القنوات والمواقع والبرامج والصفحات، فينمو فضاء ثقافي يعلو مع كل محاولة للتفسير، ومع كل جهد في نشر الوعي، ومع كل صوت يحمل داخله طاقة اكتشاف جديدة.