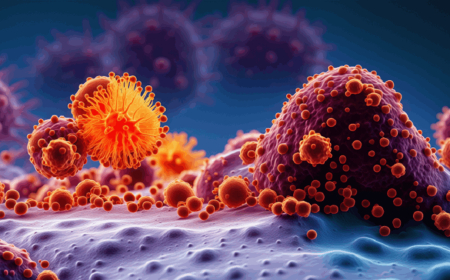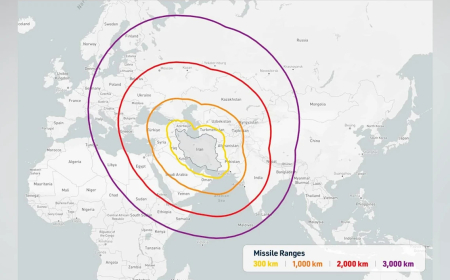التلمود عن يسوع: نعم، نحن قتلناه.. (من كتاب يسوع في التلمود» للمؤرخ والأستاذ الألماني بيتر شيفر (Peter Schäfer))
تحليل معمّق يكشف كيف رسم التلمود صورة مضادّة ليسوع تختلف جذرياً عن الأناجيل، من النسب إلى المعجزات والمحاكمة والآخرة، وفق قراءة حديثة تعتمد على أبحاث بيتر شيفر. مقال يستعرض جذور الصراع اللاهوتي بين اليهودية والمسيحية وصناعة السرديات العقائدية المتنافسة عبر التاريخ.

كتب باسم الموسوي:
لم يكن يسوع موضوعاً مركزياً في التلمود، ولم يشغل الحاخامات قديماً كما يشغل المؤرخين اليوم، غير أنّ ذكره النادر لا يقلّ أهمية عن غيابه شبه الكامل. فالمواضع التي يظهر فيها، أو يُلمَّح إليه، تكشف عن صورة مضادّة بالكامل لما تقدّمه الأناجيل عن ميلاده تعظيماً، وعن معجزاته تمجيداً، وعن موته خلاصاً. إنّ ما يقوله التلمود عن يسوع ليس نكتة عابرة ولا تعليقاً جانبياً، بل هو نصٌّ لاهوتي مكتمل، هدفه إعادة رسم شخصية يسوع بطريقة تقوّض الركائز التي بُني عليها الإيمان المسيحي كله. وهذه الصورة ليست انعكاساً لجهل اليهود بالمسيحية، بل، كما يكشف الباحث الألماني بيتر شيفر في كتابه «يسوع في التلمود»، ناتجة عن معرفة دقيقة بالأناجيل وعلى رأسها إنجيل يوحنا، ورغبة واضحة في إنتاج سردية يهودية موازية تكسر سردية الكنيسة.
منذ الجملة الأولى، يبدو واضحاً أن الحاخامات لم يسعوا إلى تقديم رواية تاريخية عن يسوع، بل أرادوا الحديث عنه بقدر ما يتيح لهم الدفاع عن اليهودية في وجه ديانة صاعدة تستمد قوتها من ادعاء أنها امتدادٌ للنبوة التي قام عليها التاريخ اليهودي. في هذا السياق، يتحول يسوع في التلمود إلى مادة جدلية، إلى شخصية تُعاد صياغتها من أجل تثبيت حدود الهوية اليهودية أكثر مما تُقدَّم كموضوع سردي مستقل. ولذلك نجد أنّ كل تفصيل تلمودي عن يسوع يرتبط بهدف نقدي محدد: نزع الشرعية عن أصله، والحطّ من سلوكه، ونفي قداسته، والتشكيك بقوته، وتدمير فكرة قيامته، بل وتحويل موته من مأساة خلاصية إلى عقوبة مستحقة فرضتها العدالة اليهودية.
تبدأ السردية التلمودية من نقطة تقويضية لا مفرّ منها: الأصل والنسب. فإذا كان الإنجيل قد بنى مسيحانية يسوع على ولادة عذراوية وعلى نسب داودي يربطه مباشرة بسلالة الحكم المقدّسة في إسرائيل، فإنّ التلمود يختار أن يبدأ من النقطة المقابلة تماماً، فيقدّم يسوع باعتباره ابن امرأة اسمها مريم، لكن مريم هذه ليست العذراء المصونة، بل امرأة متهمة بالخيانة الزوجية. وبدلاً من الروح القدس الذي يرفرف على النص الإنجيلي، يظهر في التلمود رجل آخر: جندي روماني يُدعى بانثيرا أو بانديرا، يتحول إلى الأب البيولوجي للمولود الذي سيصبح لاحقاً محور الديانة المسيحية. ليست هذه الرواية التلمودية تهكماً لغوياً فحسب، بل هي تفكيك لاهوتي متعمد: فإذا كان المسيح ابن زنا، فهو غير مؤهل لأن يكون ابن داود، وبالتالي لا يمكنه أن يكون المسيح المنتظر، ويصبح كل البناء المسيحي حول ولادته معلقاً في الهواء.
ومع أنّ الحاخامات لا يجرون وراء التفاصيل السردية، إلا أنهم يصرّون على تصوير مريم بوصفها امرأة ذات سلوك مشبوه، تتجول بشعرها المنفلت على غير عادة نساء الفقه اليهودي، ما يجعلون منه علامة على أنها ليست امرأة محافظة، بل ربما شخصية منحرفة الأخلاق. وهكذا ينتهي القارئ التلمودي إلى صورة لا يلتقي فيها اسم مريم مع أي دلالة من دلالات القداسة التي حملها عبر القرون في الوعي المسيحي.
بعد قضية النسب، ينتقل التلمود إلى تصوير يسوع كتلميذ، وهنا تظهر واحدة من أكثر الصور قسوة في الأدب الربّاني: يسوع ليس معلماً، ولا صاحب كاريزما، ولا قائداً روحياً، بل هو طالب فاشل في حلقات الرابانيين، تمرد على معلمه، وأفسدته رغباته الشخصية، فذهب يؤسس لنفسه تعليماً بديلاً. إنّ تحويل المسيحية إلى نتيجة “خطأ تربوي” أو “تمرّد تلميذ” ليس مصادفة، بل هو محاولة واعية لتقزيم تأسيس الدين الجديد، ونزع أي إيحاء بأنه وحيٌ جديد حلّ محل التوراة. وهكذا يصبح يسوع، في التلمود، رمزاً للانفلات الأخلاقي قبل أن يكون صاحب رسالة، وتتحول دعوته إلى انشقاق فردي لا إلى حدث لاهوتي.
ثم تأتي المرحلة الثالثة في إعادة رسم صورة يسوع: علاقة هذا الرجل بالمعجزات. فالأناجيل تبني جزءاً كبيراً من قداسته على معجزات الشفاء وإحياء الموتى وطرد الأرواح الشريرة. أمّا التلمود فلا ينكر وجود قوة في اسم يسوع، لكنه يسارع إلى تفسيرها بنظرية السحر. فإذا شُفي أحدهم على اسم يسوع، فالشفاء ليس آية بل “سحر”، والسحر في الفقه اليهودي محرّم، بل يوجب العقوبة. وقد يصل الموقف التلمودي إلى حدّ تفضيل موت المريض على أن يُشفى باسم يسوع، لأن الإقرار بقوة هذا الاسم عندهم يعني الاعتراف – ولو ضمناً – بشرعية المسيحية. وبذلك يرد التلمود على المعجزة المسيحية ليس عبر نفي قدرتها، بل عبر إعادة تصنيفها من “معجزة إلهية” إلى “سحر نجس”، فيتقوّض أساس النبوة التي تقوم عليها المسيحية.
غير أنّ ذروة الصدام التلمودي مع الرواية المسيحية تظهر في السردية المتعلقة بمحاكمة يسوع وإعدامه. ففي حين تروي الأناجيل مساراً معقداً تتداخل فيه مسؤولية اليهود مع سلطة بيلاطس البنطي، ينقل التلمود المسؤولية كاملة إلى الساحة اليهودية، ويقول بصراحة لافتة إنّ يسوع أُعدم بقرار يهودي وعلى أساس شريعة موسى نفسها. وبدلاً من الصلب الروماني، يتحدث النص الربّاني عن الرجم ثم تعليق الجسد، وهو العقاب المخصص في التوراة لأخطر المذنبين. وتؤكد الرواية التلمودية أنّ الحكم صدر بعدما نودي في الشوارع طلباً لمن يشفع للرجل أو يدافع عنه، فلم يتقدّم أحد، فصار تنفيذ الإعدام أمراً لا لبس فيه. واللافت أنّ هذا السرد لا يقدّم اليهود بوصفهم أبرياء من دم المسيح، بل بوصفهم أصحاب الحق في إعدامه، بل ويضفون على ذلك مسحة من الفخر. وهكذا يتحول الاتهام المسيحي التاريخي “أنتم قتلتم المسيح” إلى اعتراف ربّاني، ولكن تحت عنوان: “نعم، نحن قتلناه… لا ظلماً، بل عدلاً”.
بهذا يتضح أن الحاخامات لم يخشوا الاتهام، بل قلبوه إلى حجة دفاعية: لم نقتل مسيحاً بريئاً، بل ساحراً مضلّلاً، وهذه العقوبة مستحقة. في اللحظة نفسها التي سعت فيها المسيحية إلى إلقاء اللوم على اليهود، جاءت السردية اليهودية لتقول: إن كان ثمة قتل، فقد كان واجباً، وإن كانت هناك جريمة، فهي جريمة يسوع نفسه، لا جريمة اليهود.
ومع أنّ هذا الصدام يصل إلى ذروته في قصة الإعدام، فإنه لا ينتهي عندها، بل يمتد إلى ما بعد الموت. فبينما تقوم المسيحية على فكرة القيامة والغفران والانتصار على الموت، يذهب التلمود إلى نقيض ذلك تماماً، فيصف يسوع وهو يتعذّب في عالم الآخرة تعذيباً فاضحاً، ويُلقى به في مواد نجسة، في مشهد يجمع بين السخرية والقسوة، ويهدف إلى تدمير القداسة التي تحيط بجسد المسيح. هذا المشهد، بحسب تحليل شيفر، ليس اعتباطياً، بل موجّه مباشرة ضد طقوس الخبز والخمر، وضد الإفخارستيا التي تجعل من جسد المسيح مادة خلاصية. التلمود هنا ينتج ما يمكن تسميته “صورة مضادة للقداسة”: فإذا كان الجسد مقدّساً في المسيحية، فالتلمود يقدّم الجسد نفسه وقد انقلب إلى رمز للنجاسة.
هذه الصورة القاسية، الممتدة من الميلاد حتى الآخرة، لا يمكن فهمها خارج السياق التاريخي. ففي بابل، حيث كُتبت أغلب هذه النصوص، كانت اليهودية تعيش في ظلّ الحكم الساساني، بعيداً من سلطة الكنيسة ونظامها. هناك فقط استطاع الحاخامات أن يتحدثوا بحرية عن المسيحية، وأن يصوغوا خطاباً نقدياً صارخاً، فيما كان التلمود الفلسطيني أكثر حذراً بسبب تغلغل السلطة المسيحية في الأرض المقدسة. ولولا هذه الحرية النسبية في بابل، لربما اندثرت كثير من هذه الروايات، أو لم تُكتب أصلاً.
ومع أنّ هذا المقال يعرض صورة شديدة السلبية ليسوع داخل الأدب التلمودي، إلا أنّ دلالاتها أعمق من مجرد الشتم أو الازدراء. فهي تعبير عن صراع هويات، وعن محاولة كل دين أن يحدد مكانه أمام الآخر. المسيحية رأت نفسها تحقيقاً للنبوة اليهودية، فيما رآها الحاخامات انشقاقاً خطيراً على التوحيد. وبين هذين الموقفين، ولدت هذه السرديات التي لا تزال، بعد قرون، تكشف مدى حدّة هذا التنازع على “الحقيقة”، وعلى من يملك حق الحديث باسم الله.
في نهاية المطاف، ما يقوله التلمود عن يسوع ليس مجرد رواية تاريخية، بل هو إعلان موقف عقائدي: يسوع، في عين اليهود الربّانيين، ليس المسيح المنتظر، ولا النبي الموعود، ولا الإنسان الإلهي الذي يُنسب إليه الخلاص. إنه شخص مضلّ، ونتاج خطيئة أخلاقية، ومؤسس لطائفة مرفوضة، وقد مات الموت الذي يستحقه. ومن هنا تأتي الجملة التي تلخّص هذا الموقف بأقسى ما يمكن أن يُقال: نعم، نحن قتلناه… لأن الشريعة أمرتنا بذلك، ولأننا لم نرَ فيه إلا من يستحق العقاب.
بهذه اللغة، يضع التلمود أحد أقدم وأوضح خطوط الفصل بين اليهودية والمسيحية، لا كديانتين متجاورتين، بل كعقيدتين متصارعتين على الرواية، على التاريخ، وعلى المعنى.