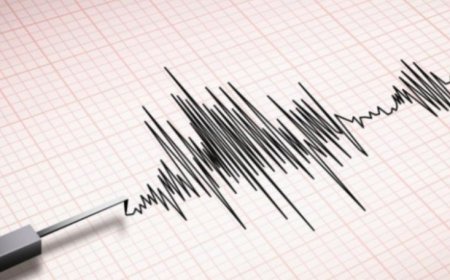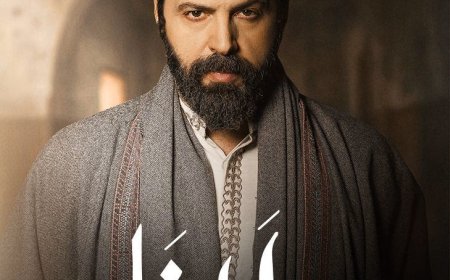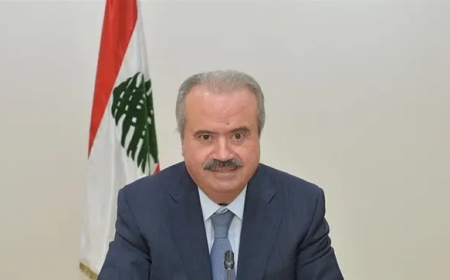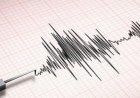الإسلام بوصفه حلًا لأزمة السيادة في أواخر العصور القديمة
تحليل تاريخي–سياسي لظهور الإسلام بوصفه استجابة لأزمة سيادة عميقة في أواخر العصور القديمة، بعيدًا عن قراءات القطيعة الدينية، بالاستناد إلى كتاب Arabs and Empires before Islam، وفهم جديد لعلاقة الدين بالسياسة والشرعية.

كتب باسم الموسوي:
لم يظهر الإسلام في فراغ تاريخي، ولا يمكن فهم نشأته بوصفها مجرّد قطيعة دينية مع الماضي، أو انفجارًا روحيًا مفاجئًا في بيئة «جاهلية» ساكنة. إنّ ظهوره، كما تكشفه القراءة التاريخية–السياسية المتأنية التي يتيحها كتاب Arabs and Empires before Islam، كان استجابة مركّبة لأزمة سيادة عميقة ضربت المجال السياسي في المشرق العربي وأطرافه خلال أواخر العصور القديمة. لقد جاء الإسلام بوصفه حلًا تاريخيًا لأزمة حكم، لا مجرد خطاب إيماني معزول عن شروطه الزمنية.
في القرن السادس الميلادي، كانت الإمبراطوريتان المهيمنتان في الشرق الأدنى—البيزنطية والساسانية—قد دخلتا مرحلة إنهاك بنيوي طويل. فالحروب المتكررة بينهما، الممتدة من القوقاز إلى اليمن، استنزفت الموارد العسكرية والمالية، وأضعفت القدرة على الضبط الفعلي للأقاليم الطرفية. لم تعد الدولة الإمبراطورية قادرة على ممارسة سيادة مباشرة ومستقرة على فضاءات شاسعة، بل راحت تعتمد على أنماط حكم غير مباشرة، قائمة على التحالف مع قوى محلية، وفي مقدمتها التكوينات العربية.
هنا برز نظام «العرب الحلفاء» أو الممالك الوكيلة: الغساسنة في خدمة بيزنطة، واللخميون في خدمة فارس. لم تكن هذه الكيانات مجرد قبائل بدوية هامشية، بل تشكيلات سياسية وعسكرية ذات بنى قيادية، لعبت دور الوسيط بين المركز الإمبراطوري والفضاء الصحراوي. غير أنّ هذا النظام نفسه بدأ يتفكك في أواخر القرن السادس. فمع اشتداد الصراع الإمبراطوري، تقلّصت هوامش استقلال هذه الكيانات، وتراجعت الثقة المتبادلة بينها وبين مراكز القرار الكبرى. انتهى الأمر بسقوط الحيرة عام 602م، وانحلال الدور السياسي الفعلي للغساسنة، ما أدى إلى انهيار الإطار الذي كان ينظم علاقة العرب بالنظام الدولي القائم آنذاك.
هذا الانهيار لم يكن مجرد حدث عسكري أو إداري، بل مثّل تفككًا في بنية السيادة ذاتها. فالعرب، الذين اعتادوا العمل ضمن منظومات إمبراطورية—سواء كمحاربين أو حلفاء أو وسطاء—وجدوا أنفسهم أمام فراغ سياسي متنامٍ. لم تعد الإمبراطوريات قادرة على فرض شرعية مقنعة، ولا على توفير الأمن أو العدالة أو الأفق السياسي. وهكذا تحوّلت الجزيرة العربية من هامش تابع إلى مجال مفتوح لإعادة تشكيل السلطة.
في هذا السياق، تكتسب مسألة الشرعية مركزيتها. فالإمبراطوريات المتأخرة لم تكن تعاني فقط من ضعف عسكري، بل من أزمة أخلاقية–سياسية عميقة. كانت السلطة في بيزنطة وفارس مشتبكة على نحو وثيق باللاهوت، وقد أدّت الصراعات المذهبية، والانقسامات الدينية الحادة، إلى تقويض فكرة الحكم العادل الجامع. في المقابل، كانت الجزيرة العربية فضاءً تعدديًا دينيًا: وثنيات محلية، يهودية، مسيحيات متعددة المشارب، دون سلطة كهنوتية مركزية قادرة على فرض هيمنة رمزية شاملة. هذا التعدد، مقرونًا بانهيار المرجعيات الإمبراطورية، خلق فراغًا شرعيًا بامتياز.
لكن هذا الفراغ لم يكن سلبيًا خالصًا. فالعرب قبيل الإسلام لم يكونوا جماعات بلا تجربة سياسية. لقد راكموا خبرات في التنظيم، والحرب، والدبلوماسية، وإدارة التحالفات. عرفوا أشكال قيادة تتجاوز العائلة الصغيرة، وامتلكوا شبكات تواصل وتجارية واسعة. ما افتقدوه لم يكن القدرة، بل الإطار الجامع: سلطة تتجاوز العصبية القبلية دون أن تعيد إنتاج الخضوع لإمبراطورية خارجية.
هنا تحديدًا يبرز الإسلام بوصفه مشروع سيادة جديد. فخطابه لم يكن دينيًا صرفًا، بل تأسيسيًا بامتياز. لقد أعاد تعريف مصدر الشرعية، لا بوصفها منحة إمبراطورية أو نسبًا عرقيًا أو قوة عسكرية، بل بوصفها التزامًا أخلاقيًا جامعًا، قوامه التوحيد والعدل والمسؤولية. بهذا المعنى، قدّم الإسلام إجابة على سؤال الحكم: من يحكم؟ وبأي حق؟ ولأجل ماذا؟
الأهم أنّ هذا المشروع لم يُطرح من خارج السياق العربي، بل انبثق من داخله، مستندًا إلى لغته، وأعرافه، وتجربته التاريخية، مع تجاوز حدودها الضيقة. لقد وحّد الإسلام بين الدين والسياسة لا على طريقة الإمبراطوريات اللاهوتية المتأخرة، بل عبر إخضاع السلطة لمعيار أخلاقي متعالٍ عليها. فالسيادة في التصور الإسلامي المبكر ليست سيادة إمبراطورية توسعية بالضرورة، بل سيادة جماعة سياسية جديدة، مؤسسة على العدل، لا على الامتياز.
من هذا المنظور، لا يعود الإسلام حدثًا استثنائيًا خارج التاريخ، ولا مجرد استمرارية دينية لما سبقه، بل لحظة إعادة تأسيس للسيادة في فضاء أنهكته الإمبراطوريات. لقد مثّل انتقالًا من منطق التبعية والوساطة إلى منطق الكيان السياسي المستقل، القادر على إنتاج شرعيته من داخله.
إن قراءة ظهور الإسلام بهذه العدسة الفكرية–السياسية لا تنتقص من بعده الديني، بل تعيده إلى مكانه التاريخي الصحيح: بوصفه حلًا لأزمة سيادة عميقة في أواخر العصور القديمة، وصيغة جديدة للحكم في عالم فقد توازنه القديم. وهي قراءة تتيح لنا، اليوم، فهم الإسلام لا كاستثناء حضاري، بل كفاعل تاريخي تشكّل في قلب التحولات الكبرى التي أعادت رسم خريطة العالم القديم.