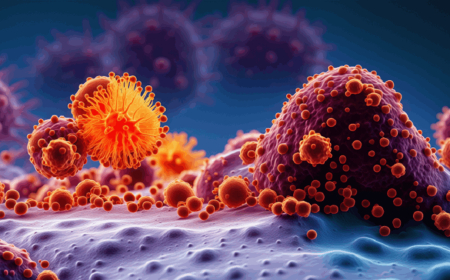خرائط العودة الى الطفولة

كتبت نور الهدى سعيدي في موقع المعنى
آلاف الصور تنهمر على الشاشات، وجوه ناضجة تعانق أشباحها الصغيرة، أذرع تلتف حول طفولة منشأة بالذكاء الاصطناعي. المشهد يبدو بريئًا، حتى مؤثرًا، استدار الزمن فيه ووضع الحاضر في حضن الماضي. في لحظة التبس فيها الشعور، من يعانق من حقًا؟ أيمدّ الكبير ذراعيه ليحمي الطفل الذي كانه، أم يمدّ الصغير ذراعيه ليحفظ ما تبقى من براءة في الكائن المنهك أمامه؟
لكن، هل نعانق أنفسنا حقًا أم نعانق وهمًا بصريًا صنعته خوارزمية؟ وماذا لو كانت هذه الصور مجرد استغلال ذكي للحنين، تكنولوجيا تتاجر بالذاكرة وتبيعنا مشاعرنا محسّنة رقميًا؟ السؤال لا يفسد التجربة، بل يضيف إليها طبقة نقدية ضرورية.
الصورة لا تقدّم ترفًا عاطفيًا، بل تفتح حيزًا للتأمل في علاقتنا بأنفسنا. نرى الجسد وهو يكتب بما تبقى فيه من رسائل غير مقروءة، تجعيدات كتبتها المخاوف، وندوب وضعت نقطتها الأخيرة على سرديات قديمة. في الالتفاف الهادئ للذراعين جملة تقول إن الماضي ليس متحفًا يزار، بل عضلة تستعيد قوتها كلما تذكرنا استعمالها بلطف.
ولأن الحنين وحده لا يكفي، تقترح هذه العودة مسافة جديدة بين الطفولة والكبر. ليست الطفولة هناك والكبر هنا، بل كلاهما يعملان في الجسد نفسه بوتيرتين متعاقبتين، الأولى تعيد الدهشة إلى الحواس كي ترى التفاحة كوكبًا صغيرًا لا ثمرة فحسب، والثانية تمنح التجربة حيلة البقاء دون أن تفسد نبرة الفرح. عند هذا التقاطع الهادئ، يصبح العناق تدريبًا على معنى أبسط للغفران، ويغدو الزمن أقل حدّة وأكثر اتساعًا لما يمكن أن يُعاش الآن.
كلما التصقت الخدود في تلك الصور، بدا الجسد دفترًا يدوّن بالملمس لا بالحبر. الكتف صفحة قابلة للحوار، واليد هامش يدوّن ملاحظات عن خوف قديم وطمأنينة مستجدة. تُصلح اللمسة ما أفسدته لغة صارمة اعتدناها مع أنفسنا، وتعيد ترتيب الكلمات الداخلية من صيغة الأمر إلى صيغة الرجاء.
لا تنكشف الحقيقة دفعة واحدة؛ تتسرب مثل ماء صبور من شِقّ صغير في الجدار. التقنية، التي نتّهمها بالبرود، لا تزيد هنا على أن تكون الريح التي أيقظت الماء النائم من ركوده. الصورة المصنوعة توقظ إحساسًا طبيعيًا كدنا نفقده، رغبتنا في أن نرى أنفسنا بلا وسطاء. وهنا يتبدّل موقع الذكاء الاصطناعي من خصمٍ محتمل إلى مرآة تساعد على قراءة نص كان حاضرًا ولم نكن نلتفت إليه.
لكن التقنية هنا تلعب دورًا مزدوجًا: تعيد إلينا إحساسًا طبيعيًا كدنا نفقده، لكنها تعيده مُصنعًا، مُعالجًا، مُحسنًا. هل هذا إنقاذ للذاكرة أم تزييف لها؟ ربما كلاهما معًا. المرآة الرقمية تعكس ما نريد رؤيته، لا ما كان عليه الواقع فعلًا.
عين الكبير التي تتطلع إلى الطفل تسأل: هل خنتك وأنا أتعلم القسوة لأصمد؟ وعين الطفل تجيب بلمعان واضح، القسوة مهارة بقاء، لكنها ليست بيتًا للإقامة. بين سؤال ولمعان تتشكّل منطقة ثالثة لا تبرّر ما مضى ولا تدينه، بل تمسكه مثل كرة مطاطية وتعيد قذفها إلى الأمام، لا لتصيب أحدًا، بل لتذكّر اليد بإيقاعها الأول.
الذاكرة الحسية تُكمل ما تعجز عنه بلاغة الصورة المُصنعة. رائحة الطباشير قادرة على استدعاء صفٍ كامل، وصوت مفاتيح الأب كفيل بإعادة بناء غرفة جلوس منسية. هذه التفاصيل لا تحتاج إلى معالجة رقمية؛ تحتاج إلى نافذة تُفتح بالقدر المناسب، إلى ضوء متروك في الممر. الرجوع الحقيقي ليس عبر الشاشة، بل التفاتة مضبوطة إلى ما يسكن فينا بلا تجميل.
يفتح العناق الزمني ملف الحياة اليومية. أن تضع يدًا على رأس من كنته يعني أن تراجع معيار الإنجاز الذي يقيس النفس بما تُنتج لا بما تُنقذ. يعني أن تُعيد للجسد إجازاته الصغيرة: نومًا بلا ذنب، نزهة بلا هدف، قهوة تُشرب حتى تبرد. ليست هذه كماليات؛ إنها أدوات الوقاية من القسوة الوجودية، حين تتنكر في هيئة كفاءة. يحل هنا سؤال جديد: كيف نحافظ على هذا الخيط دون أن نشده حتى ينقطع؟
في خلفية كل حضن ظلّ منخفض لتغير مقبول، سنكبر أكثر، وستتراكم الأيام بغبارها المعتاد. لكن الظل لا يهدد ما دام المقبض في اليد واضحًا. يمكن لتمرين صغير أن يثبت المقبض كل صباح، جملة دافئة تقال للذات، دقيقة صمت قبل بداية اليومي، تذكّر متعمد بلعبة قديمة حتى لو لم نجدها. ليست وصفات تُنشر، بل عادات سرية للمقاومة والاستمرار.
الطفولة لا تُستعاد كديكور، بل كمنطق إدراك. هي طريقة في رؤية الأشياء حين كانت تسمياتها شفافة، الحجر رفيق لعب، الغيمة وعد ماء، السقوط تجربة لا عيبًا. عندما نسمح لهذا المنطق أن يمر عبر الكبر، نصير أقدر على اختيار ما يستحق أن يثقل الكتفين وما يجب أن يتبخر. الحكمة ليست ضد الدهشة؛ الحكمة تنظيمٌ رقيق لمرورها.
لكن هنا تكمن المخاطرة، أن نتحول إلى سياح في ذكرياتنا المُصنعة. أن نصدق أن الماضي كان أجمل مما كان عليه، أو أن الطفولة كانت أنقى من حقيقتها. الصورة المُعالجة تمحو التفاصيل المؤلمة وتبقي على اللمعان فقط. المصالحة مع الذات الأولى تُخفف اليد من أعناق الآخرين، فيصبح الحكم أبطأ، والتأويل أرحب. مدينة صغيرة في الداخل تهدأ، فتستطيع المدينة الكبيرة أن تتنفس قليلًا.
الجسد الذي أنهكته المطالب يتعلم أن يعود إلى وظيفة أقدم، أن يكون بيتًا لا آلةً. حين نضع كفًّا على القلب كما لو كان كائنًا يحتاج رعاية، نفهم أن الثقل الذي نحمّله له ليس كله ضروريًا. بعضه زينة اجتماعية، وبعضه خوف مؤجل، وبعضه صمت ورثناه ونستطيع أن نضعه في الخزانة.
في هذه العودة لا تُلغى الخسارات، لكنها تُراجع. نتعرف إليها بلا انفعال زائد، كما يتعرف حرفيّ قديم إلى أداة خدشته ثم اعتادها. البطولة ليست أن نمحو الألم، بل أن نمنعه من كتابة كل السطور.
الموت كذلك لا يُطرد من المشهد. يكفي أن نعيده إلى موضعه كي يستقيم الميزان. كان الطفل أول من تعلّم معناه من ورقة صفراء سقطت بلا إنذار. لم يرتعب؛ وضعها في كتابه ثم أكمل اللعب. تلك الحكمة ما تزال صالحة، نمنح الفقد اسمًا هادئًا، ونواصل ترتيب الطاولة لمن حضر.
ولأن الصورة فتحت الباب، يمكن للخطوات أن تتبعها في الواقع. زيارة لمكان طفولة إن أمكن، أو ركن صغير يُختار في البيت ويُعلن حيزًا للبطء، أو ورقة تُكتب بخط اليد: “اليوم لا يتكرر”. هذه التفاصيل لا تصنع ثورة، لكنها تحمي المعنى من التآكل الهادئ.
يبقى أن ننتبه للفخ المقابل، تحويل العودة إلى مشروع للصورة وحدها. ما يُنشر على الصفحات يظل ظلًا، أما النص الحقيقي فيُكتب بعيدًا عن الضوء القوي. يمكن أن نلتقط صورة واحدة ونكتفي، ثم نترك لبقية الأيام عملها الصامت. فالمعنى يتغذى من العادة أكثر مما يتغذى من الحدث.
حتى إذا صادفت نفسك تعانق من كنته في لقطة مصنوعة، فاسمح للصورة أن تنجز مهمتها ثم أطفئ الشاشة قليلًا. جرّب أن تُعيد يدك إلى الموضع نفسه بلا كاميرا، وأن تُنصت لما يتغير في إيقاع النفس. ستكتشف أن الطريق يتسع خطوة واحدة، وأن البيت الداخلي يعثر على خريطته التائهة، وأن الزمن حين يهدأ يترك لنا مساحة كافية لنكون ظلين اثنين يعملان معًا في جسد واحد.