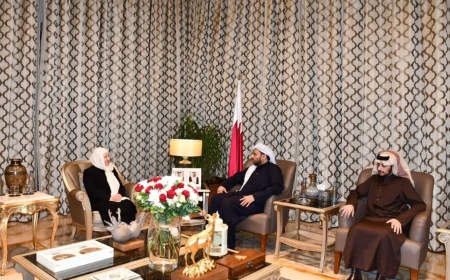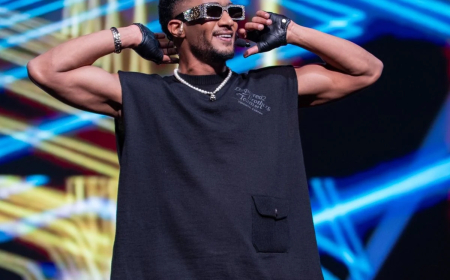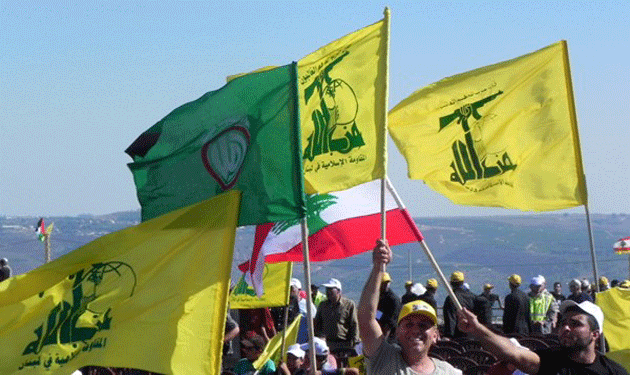من نقد الدين إلى موت الإنسان الخُلقي مأزق التنوير العربي المعاصر بين التحرّر ونزع المعنى
يناقش المقال إشكالية نقد الدين في الفكر العربي المعاصر، من مشروع التنوير إلى تفكيك المرجعية الأخلاقية، ويطرح مفهوم «موت الإنسان الخُلقي» بوصفه نتيجة لفصل الحرية عن الإلزام والمعنى، مع قراءة نقدية لأعمال محمد أركون، نصر حامد أبو زيد، وأدونيس.

كتب باسم الموسوي:
لم يكن نقد الدين في الفكر العربي المعاصر مجرّد تمرين معرفي محايد، بل شكّل، منذ سبعينيات القرن العشرين، أحد أهم رهانات “التنوير” العربي، وسُوِّق بوصفه شرطًا لتحرير الإنسان من السلطة، ومن التقليد، ومن كلّ أشكال الوصاية الرمزية التي كبّلته تاريخيًا. غير أنّ هذا النقد، في صِيَغه الأبرز، انتهى إلى مفارقة عميقة: إذ بينما سعى إلى تحرير الإنسان، ساهم – بنيويًا – في إفراغه من الأساس الأخلاقي الذي يمنح أفعاله معنى إلزاميًا، فكان الناتج إنسانًا حرًّا بلا مسؤولية، وذاتًا واعية بلا بوصلة. هكذا يمكن الحديث عن ظاهرة لا تقلّ خطورة عن “موت الإله” أو “موت الإنسان” في الفكر الغربي، وهي ما يمكن تسميته بـ موت الإنسان الخُلقي.
لا يُقصد بهذا التعبير إعلان نهاية الأخلاق أو انعدام السلوك القيمي في المجتمعات العربية، بل توصيف تحوّل أعمق: انهيار المرجعية المتجاوزة التي تجعل الفعل الأخلاقي ملزِمًا، لا مجرّد خيار ذاتي أو تفضيل ثقافي أو تأويل شخصي. فالإنسان، في هذا الأفق، لا يكفّ عن الفعل، لكنه يفعل بلا أفق محاسبة يتجاوز الذات، وبلا غاية تُنقذ أفعاله من النسبيّة والسيولة.
نقد الدين: من التحرير إلى التفكيك
انطلقت مشاريع نقد الدين العربية الحديثة من فرضية مركزية مفادها أنّ المأزق التاريخي للمجتمعات العربية–الإسلامية يكمن في هيمنة المقدّس على العقل، وأنّ التحرّر يقتضي تفكيك هذا المقدّس وإخضاعه لمناهج الحداثة النقدية: التاريخ، والأنثروبولوجيا، واللسانيات، والتأويل. غير أنّ هذه المشاريع، على اختلاف منطلقاتها، التقت عند نتيجة واحدة: تحويل الدين من أفق معياري موجِّه إلى خطاب ثقافي منزوع الإلزام.
في هذا السياق، يُقرأ مشروع محمد أركون بوصفه مثالًا واضحًا على هذا المسار. فقد سعى إلى “أنسنة” الدين عبر إخضاعه للأدوات الأنثروبولوجية والتاريخية، وكشف “اللامفكَّر فيه” داخل الخطاب الإسلامي. غير أنّ هذه العملية، على أهميتها النقدية، أدّت إلى نتيجة إشكالية: إذ أصبح الدين موضوع معرفة، لا مصدرًا للواجب؛ مادة تحليل، لا أفق التزام. ومع تراجع البعد المعياري، لم يبقَ من الدين سوى سرديات متنازعة، بلا قدرة على إنتاج إلزام أخلاقي جامع.
أما نصر حامد أبو زيد، فقد ركّز مشروعه على تاريخية النص وأولوية القارئ، معتبرًا أنّ المعنى نتاج التفاعل بين النص والسياق. غير أنّ هذا التركيز، حين انفصل عن سؤال المرجعية، قاد إلى مأزق أخلاقي صامت: فإذا كان المعنى دائم التشكل، وإذا كانت القراءة لا تخضع إلا لشروطها التاريخية، فما الذي يجعل القيم ملزمة؟ وكيف يمكن التمييز بين تأويل أخلاقي وآخر عدمي؟ هنا يتحوّل الإنسان إلى ذات حرة تأويليًا، لكنها معلّقة معياريًا، بلا أرض صلبة تقف عليها.
ويبلغ هذا المسار ذروته في مشروع أدونيس، الذي لا يكتفي بنقد المؤسسة الدينية، بل يعلن قطيعة جذرية مع المقدّس نفسه. فالدين، في نظره، بنية تقليدية قمعية، والشعر–الذات هو البديل. غير أنّ هذا الاستبدال، رغم طابعه الإبداعي، يفضي إلى سيادة ذات بلا معيار، وإلى أخلاق جمالية لا تملك قوة الإلزام. هنا لا يُقتل الإله فقط، بل يُترك الإنسان بلا بوصلة.
من “موت الإله” إلى “موت الإنسان الخُلقي”
يذكّر هذا المسار بما عرفه الفكر الغربي منذ نيتشه، حين أُعلن “موت الإله” بوصفه شرطًا لتحرّر الإنسان. لكن التجربة الغربية نفسها كشفت أنّ هذا الموت لم يؤدِّ إلى سيادة إنسان متماسك، بل إلى أزمة معنى عميقة، وإلى ذات مثقلة بالاختيار، ومنهكة بالحرية. وقد عبّر فوكو لاحقًا عن هذا المأزق بمقولة “موت الإنسان”، حين تبيّن أنّ الإنسان الذي أُقيم مركزًا لكلّ شيء لم يحتمل هذا الحمل.
في السياق العربي، يتكرر المشهد لكن بصورة مشوّهة: إذ استُورد نقد الدين دون استيعاب نتائجه الوجودية والأخلاقية. فتمّ تفكيك المرجعية دون بناء بديل معياري قادر على أداء وظيفة الإلزام. والنتيجة ليست تحرّرًا، بل فراغًا. وهنا يمكن الحديث عن موت الإنسان الخُلقي: أي إنسان فقد العلاقة بين الحرية والمسؤولية، بين الفعل والمعنى، بين الاختيار والمحاسبة.
هذا الموت ليس حدثًا دراميًا، بل عملية صامتة. يظهر في انتشار النسبية الأخلاقية، وفي اختزال القيم إلى آراء، وفي تحويل الأخلاق إلى مسألة ذوق أو موقف سياسي أو هوية ثقافية. ومع غياب المرجعية المتجاوزة، تُحمَّل الذات عبئًا لا تُطيقه: أن تكون مصدر القيم، وغايتها، وحَكَمها الوحيد. وحين تعجز، تُتَّهم بالقصور بدل مساءلة الإطار الذي وضعها في هذا المأزق.
الذات المأزومة ونزع الإلزام
لا يمكن فهم هذا التحوّل بمعزل عن أزمة الذات الحديثة عمومًا. فالذات التي بشّرت بها الحداثة – ذات مستقلة، عاقلة، حرة – تحوّلت، مع الوقت، إلى ذات منهكة، مثقلة بالمسؤولية، محرومة من الأفق المتجاوز. وفي الفكر العربي، جاءت مشاريع نقد الدين لتُعمّق هذا المأزق بدل أن تحلّه، لأنها فصلت الحرية عن الغاية، والعقل عن المعنى، والتحرّر عن الأخلاق.
إنّ الأخلاق، في جوهرها، ليست مجرّد منظومة سلوك، بل علاقة بين الإنسان وما يتجاوزه. وحين تُقطع هذه العلاقة، لا يبقى من الأخلاق سوى خطاب وعظي أو تنظيم قانوني أو تفضيلات شخصية. وهذا ما يجعل “موت الإنسان الخُلقي” أخطر من موت الإله نفسه؛ لأنه يعني بقاء الإنسان حيًّا بلا معيار، فاعلًا بلا غاية، حرًّا بلا مسؤولية.
نحو أفق نقدي بديل
لا يعني هذا النقد الدعوة إلى العودة الساذجة إلى أشكال تقليدية من التدين، ولا الدفاع عن سلطة دينية مغلقة، بل الإشارة إلى ضرورة إعادة التفكير في شرط الإلزام الأخلاقي. فالنقد الذي يكتفي بتفكيك المرجعيات دون إعادة تأسيس المعنى، يتحوّل من أداة تحرّر إلى أداة تفريغ.
إنّ الحاجة اليوم ليست إلى مزيد من نزع القداسة، بل إلى مساءلة السؤال الذي جرى طمسه باسم التنوير: كيف يكون الإنسان حرًّا ومسؤولًا في آن؟ كيف يمكن بناء أخلاق لا تختزل في الذات ولا تُفرض بالقسر؟ وكيف يمكن تجاوز الثنائية الزائفة بين سلطة المقدّس وعدمية التفكيك؟
هنا يفتح مفهوم “موت الإنسان الخُلقي” أفقًا نقديًا ضروريًا: فهو لا يرفض نقد الدين، بل يطالب بتحمّل نتائجه الأخلاقية. ولا يدعو إلى إلغاء الحداثة، بل إلى مساءلة حدودها. فالتحرّر الذي لا ينتج معنى، يتحوّل إلى عبء، والعقل الذي لا يعرف الغاية، يفقد حكمته، والذات التي تُترك بلا أفق، تنكسر من الداخل.
خاتمة
إنّ أخطر ما في التنوير العربي المعاصر ليس جرأته على نقد الدين، بل عجزه عن الإجابة عن سؤال الأخلاق بعد هذا النقد. فحين يُفكَّك المقدّس دون بناء بديل معياري، لا يولد إنسان جديد، بل يُستنزف الإنسان القائم. وهكذا لا نكون أمام تحرير للذات، بل أمام ذات مأزومة، تدور في فراغ الحرية بلا معنى، وتُجسّد، في صمت، موت الإنسان الخُلقي.