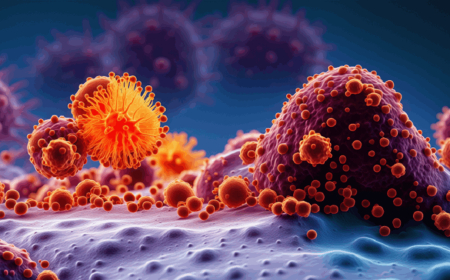تفكيك «الحضارة اليهودية–المسيحية»: في تشريح كذبةٍ مريحة وبناء ذاكرةٍ إقصائية
قراءة نقدية معمّقة لكتاب صوفي بسيس حول مفهوم «الحضارة اليهودية–المسيحية»، تكشف جذوره الأيديولوجية ودوره في إعادة تشكيل الذاكرة الغربية، وإقصاء الإسلام، وتبرير الهيمنة والاستعمار باسم القيم والحضارة.

كتب باسم الموسوي:
ليس هذا الكتاب دفاعًا عن دينٍ في مواجهة دين، ولا مجرّد منازلة فكرية حول الأنساب الروحية للحضارات، بل هو عمل تفكيكي عميق يضع إصبعه على أحد أكثر مفاهيم العصر الحديث التباسًا وخطورة: مفهوم «الحضارة اليهودية–المسيحية». في هذا النص، لا تتعامل صوفي بسيس مع المصطلح بوصفه توصيفًا بريئًا أو خلاصة ثقافية محايدة، بل باعتباره أداة أيديولوجية أُنتجت في لحظة تاريخية محددة، ثم جرى تعميمها حتى تحولت إلى بداهة لا تُسائل، وإلى مسلّمة تُستدعى لتفسير العالم وترتيبه أخلاقيًا وسياسيًا.
تنطلق بسيس من مساءلة زمنية دقيقة: متى ظهر هذا المفهوم، وكيف انتقل من دوائر لاهوتية أو أكاديمية ضيقة إلى قلب الخطاب السياسي والإعلامي؟ تُظهر أن عبارة «اليهودي–المسيحي» لم تكن، طوال قرون، إطارًا جامعًا لتعريف الحضارة الأوروبية، وأن حضورها الكثيف في اللغة العامة ظاهرة حديثة نسبيًا، ارتبطت بتحولات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تعززت مع صعود اليمين الغربي، والخطابات الهوياتية، وحروب «القيم». بهذا المعنى، لا يصف المفهوم واقعًا تاريخيًا بقدر ما يصنع واقعًا رمزيًا، ويمنح شرعيةً سردية لمن يملكون سلطة تعريف «الغرب» وحدوده.
في قلب هذا التحليل، تضع بسيس ما تسميه «الاستبدال الكبير». فالسردية الأوروبية التقليدية، التي كانت تقدّم أوروبا بوصفها وريثة الحضارتين اليونانية واللاتينية، لم تُهجر لأنها خاطئة علميًا، بل لأنها لم تعد كافية سياسيًا. لقد كان لا بدّ من سردية أكثر قدرة على التعبئة الأخلاقية، وأكثر قابلية للاستخدام في صراعات العصر. وهنا برز «اليهودي–المسيحي» بوصفه أصلًا مزدوجًا، يمنح الغرب بعدًا دينيًا–أخلاقيًا جديدًا، ويحوّل الحضارة من نتاج تاريخي متراكم إلى هوية قيمية مغلقة. هذا الاستبدال لا يُضيف عنصرًا فحسب، بل يُقصي عناصر أخرى، ويعيد ترتيب الذاكرة على نحوٍ انتقائي، حيث يُمحى الشرق من تاريخ أوروبا، أو يُستعاد فقط بوصفه مادة خامًا تم «استيعابها» وتجاوزها.
غير أن أخطر ما في هذا البناء لا يكمن في إعادة تعريف الجذور، بل في صناعة النسيان. فحين تُقدَّم اليهودية فجأة بوصفها أحد أعمدة الهوية الغربية، يُغلق ملفٌّ طويل من العداء المسيحي لليهود دون مساءلة بنيوية. قرون من الاضطهاد، من القوانين الإقصائية، من الغيتوهات، من المجازر، ومن التعليم اللاهوتي المعادي لليهود، تُختزل فجأة في سردية تصالحية تُعلن «الوحدة الحضارية» بأثرٍ رجعي. بهذا المعنى، لا يُلغى العنف الماضي، بل يُعاد تأطيره بحيث يفقد قدرته على الإدانة، ويتحوّل إلى فصلٍ مطويّ في كتابٍ أُعيدت كتابته.
وتبيّن بسيس أن هذا التحوّل في الذاكرة الأوروبية لا يمكن فصله عن صدمة المحرقة. فبعد النازية، لم يكن ممكنًا للغرب أن يستعيد ادعاءه الأخلاقي دون إعادة ترتيب علاقته باليهود. لكن بدل مواجهة الجذور العميقة للعداء البنيوي، جرى اختيار مسارٍ أسهل: إدماج اليهودية في تعريف الذات الغربية، وتحويل اليهود من «آخر داخلي» إلى شاهدٍ على براءة الغرب المعاصرة. وهكذا، حلّ الفيلوسامية الرسمية محلّ العداء القديم، دون أن يُلغى منطق الاستثناء، بل تغيّر اتجاهه فقط.
في المقابل، يشتغل المفهوم ذاته بوصفه آلة إقصاء للإسلام. فالإسلام، رغم كونه امتدادًا إبراهيمياً، ورغم عمق التشابك التاريخي والفكري بينه وبين المسيحية واليهودية، يُستبعد من السردية الحضارية الغربية. لا يعود جزءًا من تاريخ المتوسط، ولا شريكًا في صناعة الحداثة، بل يُعاد تمثيله بوصفه «الآخر المطلق»، الخارج عن الكوني، والمقيم في فضاء الخصوصية والعنف. وهنا تكشف بسيس كيف يُعاد إنتاج ثنائية استعمارية قديمة بلغة ثقافية جديدة: شمالٌ عقلاني، علماني، مُنتِج للقيم، وجنوبٌ ديني، تقليدي، مُهدِّد.
وتُظهر المؤلفة أن هذا الإقصاء لا يصمد أمام أي فحص تاريخي جدي. فالإسلام لم يكن هامشًا في تاريخ أوروبا، بل كان جزءًا من نسيجها: من الأندلس إلى صقلية، ومن انتقال الفلسفة اليونانية عبر الترجمات العربية، إلى أثر ابن رشد في الجامعات الأوروبية، وصولًا إلى التداخلات القانونية والإدارية في العصور الوسطى. لكن «الحضارة اليهودية–المسيحية» تعمل على قطع هذه السلاسل، لأنها تُربك سردية النقاء الهوياتي، وتُظهر أن «الغرب» لم يكن يومًا كيانًا مغلقًا على ذاته.
وترى بسيس أن هذا البناء الرمزي اكتسب قوة إضافية بعد قيام دولة إسرائيل. فالدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل لا يُفهم فقط في ضوء المصالح الجيوسياسية، بل أيضًا في إطار سياسة ذاكرة تجعل من إسرائيل امتدادًا أخلاقيًا للغرب، وحارسًا متقدمًا لقيمه. في هذا السياق، تُمنح إسرائيل وضعية الضحية الدائمة، بما يحصّنها من النقد، ويحوّل مساءلة سياساتها الاستعمارية إلى تهديدٍ للنظام الأخلاقي الغربي برمّته. وهكذا، يصبح الفلسطيني – مرة أخرى – خارج السردية، خارج «الكوني»، ومقيمًا في منطقة الصمت.
لكن الكتاب لا يكتفي بتوجيه النقد إلى الغرب وحده. إذ تشير بسيس إلى أن الخطابات العربية والإسلامية التي تتحدث عن «مؤامرة يهودية–مسيحية» تُسهم، من حيث لا تدري، في ترسيخ المفهوم ذاته. فهي تقبل الثنائية نفسها، وتُعيد إنتاجها معكوسة، بدل تفكيكها. وبهذا، يصبح «اليهودي–المسيحي» مفهومًا يخدم الجميع: يخدم الغرب لأنه يمنحه هوية مغلقة ومبرِّرة، ويخدم خصومه لأنه يمنحهم عدوًا مبسّطًا، واضح المعالم، يُغني عن التفكير في التعقيدات البنيوية للهيمنة والاستعمار.
في الخلاصة، لا تهدف صوفي بسيس إلى استبدال أسطورةٍ بأخرى، ولا إلى اقتراح هوية بديلة، بل إلى زعزعة منطق الأسطرة نفسه. ما تدافع عنه هو حقّ التاريخ في التعقيد، وحقّ الذاكرة في أن تكون مجال مساءلة لا أداة تبرئة. «الحضارة اليهودية–المسيحية» ليست توصيفًا للماضي، بل خطابًا عن الحاضر، عن خوف الغرب من فقدان مركزيته، وعن حاجته إلى سردية أخلاقية تُغطي تناقضاته الاستعمارية، وعن عجزه عن الاعتراف بأن الحداثة نتاج تفاعلات متعددة لا يمكن اختزالها في ثنائية مريحة.
بهذا المعنى، يشكّل هذا الكتاب نصًا بالغ الأهمية، ليس لأنه يقدّم أطروحة صادمة، بل لأنه يعرّي بداهاتنا، ويكشف أن أكثر المفاهيم تداولًا قد تكون الأكثر زيفًا. إنه دعوة إلى التفكير خارج القوالب، وإلى استعادة تاريخٍ مفتوح، متداخل، لا يُدار من فوق، ولا يُختزل في شعارات، بل يُقرأ بوصفه مسارًا إنسانيًا مليئًا بالصراع، والاختلاط، والتناقض، وهو – وحده – ما يستحق اسم الحضارة.