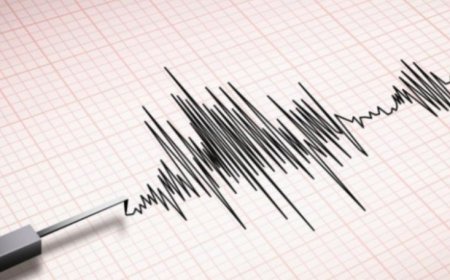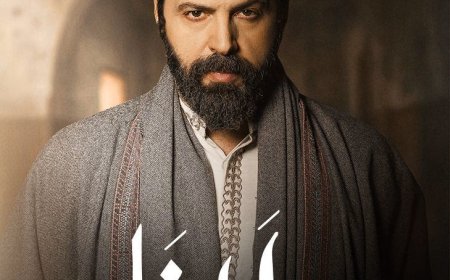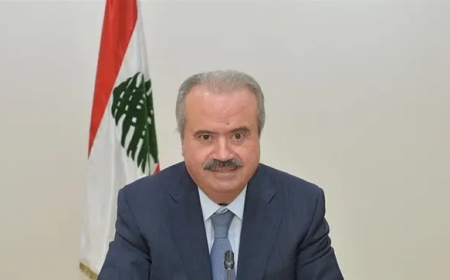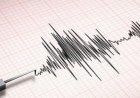السلفية في مصر: بدء التراجع

كتب باسم الموسوي:
لم يكن صعود السلفية في مصر حدثًا طارئًا ولا نتيجة اختراق خارجي مفاجئ، كما تميل السرديات التبسيطية إلى تصويره، بل كان نتاجًا تاريخيًا لتقاطع عميق بين بنية الدولة العميقة المصرية وآليات اشتغالها في الحقل الديني، وبين تدخل سعودي جاء في لحظة كانت فيها الأرض مهيأة لا للزرع بل للاستثمار. إن النظر إلى السلفية بوصفها “وافدًا” أيديولوجيًا يحجب السؤال الأهم: كيف سمح النظام المصري نفسه بتحولها إلى معيار ديني واجتماعي واسع الانتشار، بل وكيف استفاد من هذا التحول في لحظات مفصلية من تاريخه السياسي.
منذ قيام دولة يوليو، لم تتعامل السلطة في مصر مع الدين بوصفه مجالًا مستقلًا أو خصمًا دائمًا، بل بوصفه موردًا سياسيًا قابلًا للإدارة والضبط. فالدولة لم تسعَ إلى علمنة المجال الديني بقدر ما سعت إلى إخضاعه، وهو ما تجلّى بوضوح في إعادة هيكلة الأزهر وتحويله إلى مؤسسة رسمية تابعة للدولة، تُنتج خطابًا دينيًا “آمنًا” منزوع القدرة على النقد الجذري أو المساءلة الأخلاقية للسلطة. وفي المقابل، جرى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها تهديدًا سياسيًا مباشرًا، لا مجرد تيار ديني، فتعرضت للقمع المنهجي الذي حوّلها من حركة اجتماعية واسعة إلى تنظيم مطارد، ثم إلى تيارات أكثر راديكالية داخل السجون وخارجها.
هذا الترتيب أنتج فراغًا مركزيًا في الحقل الديني. الأزهر حاضر لكنه فاقد للمبادرة، والإخوان غائبون أو مشلولون، والمجال مفتوح لتيارات لا تطالب بالسلطة ولا تنازع الدولة سيادتها. في هذا السياق، برزت السلفية بوصفها خطابًا يركز على العقيدة والطقوس والسلوك الفردي، ويعلن بوضوح رفضه للعمل السياسي وتحريمه للخروج على الحاكم. هذا الخطاب لم يُنظر إليه من قبل أجهزة الدولة كخطر، بل كبديل وظيفي أقل كلفة من الإسلام السياسي المنظم، بل وكأداة محتملة لتحييد المجتمع وإعادة توجيه اهتماماته بعيدًا عن أسئلة السلطة والعدالة.
بهذا المعنى، لم تُقمع السلفية في مصر، بل تُركت تنمو داخل هوامش محسوبة. سمح لها بالانتشار في المساجد الصغيرة، وفي الأحياء الشعبية، وفي القرى، وفي الدروس غير الرسمية، لأنها لم تطالب بإسقاط النظام ولم تنازع الدولة احتكار العنف أو القرار السياسي. لقد قدّمت السلفية للدولة عرضًا غير معلن: طاعة ولي الأمر، تجريم الاحتجاج، فصل صارم بين “الدعوة” و”السياسة”، وردّ كل أزمات المجتمع إلى خلل في العقيدة لا إلى بنية الحكم أو الاقتصاد. في المقابل، حصلت على مساحة اجتماعية واسعة سمحت لها بإعادة تشكيل المعيار الديني اليومي للمجتمع.
يمكن القول إن الدولة المصرية بدأت في السنوات الأخيرة تعزيز دور الأزهر، لكن هذا التعزيز لا يمكن فهمه بوصفه استعادة لاستقلال المؤسسة الأزهرية أو إعادة إحياء لدورها التاريخي بوصفها سلطة دينية نقدية قائمة بذاتها، بل ينبغي قراءته ضمن منطق إدارة الدولة العميقة للحقل الديني بعد تحولات كبرى أصابت المشهدين الداخلي والإقليمي. فمع تراجع الإخوان المسلمين كقوة سياسية منظمة، ومع انحسار النموذج السلفي التصديري الذي كانت السعودية تمثله لعقود، وجدت الدولة نفسها أمام فراغ ديني ورمزي لا يمكن تركه دون ضبط، لأن تركه مفتوحًا يعني السماح بعودة أشكال جديدة من الإسلام السياسي أو بروز خطابات دينية عابرة للحدود لا تخضع لمنطق الدولة الوطنية.
في هذا السياق، عاد الأزهر إلى الواجهة لا بوصفه مؤسسة علمية حرة، بل باعتباره المرجعية الدينية الوطنية القابلة للإدارة. فالدولة تحتاج إلى سلطة دينية تمنح شرعية أخلاقية للنظام العام، وتوفر خطابًا إسلاميًا “آمنًا” يواجه التطرف العنيف، ويملأ الفراغ الذي خلّفه تراجع الإخوان، ويحدّ من النفوذ الاجتماعي المتراكم للسلفية ذات الجذور أو الامتدادات السعودية. غير أن هذا الدور الجديد لا يُمنح للأزهر دون شروط، إذ يجري تعزيز حضوره الإعلامي والدولي، وتقديمه بوصفه صوت “الإسلام الوسطي”، في مقابل الإبقاء على تبعيته البنيوية للدولة، سواء على مستوى التعيينات أو التمويل أو حدود الخطاب المسموح به.
أما في ما يتعلق بالنفوذ السعودي، فالأمر لا يتعلق بقطيعة مباشرة أو صراع معلن، بل بإعادة توازن داخل المجال الديني السنّي. فالسعودية نفسها لم تعد تسعى إلى تصدير السلفية كما في السابق، بل أعادت تعريف دورها الديني في إطار قومي ودولتي مختلف، بينما رأت مصر في هذا التحول فرصة لإعادة تثبيت نفسها بوصفها مركزًا دينيًا سنّيًا تاريخيًا عبر الأزهر. بهذا المعنى، يصبح تعزيز دور الأزهر جزءًا من استعادة السيادة الرمزية المصرية على الإسلام المحلي، وإعلانًا ضمنيًا بأن المرجعية الدينية في مصر تُصاغ في القاهرة لا في الخارج، حتى لو استمرت العلاقات السياسية والاقتصادية مع الرياض.
لكن هذا التعزيز يظل وظيفيًا لا تحرريًا. فالدولة تسمح للأزهر بأن ينتقد السلفية، وأن يواجه خطاب التكفير والتشدد، وأن يشارك في مبادرات “تجديد الخطاب الديني”، لكنها لا تسمح له بأن يتحول إلى سلطة أخلاقية مستقلة قادرة على مساءلة بنية الحكم أو السياسات الاقتصادية أو القمع السياسي. إن الأزهر، في صيغته المعزَّزة الحالية، مدعو إلى لعب دور الحارس العقائدي للمجتمع، لا دور الضمير النقدي للدولة. وهو بذلك يتحرك داخل هامش مرسوم بعناية: يمكنه الدفاع عن الوسطية، لكنه لا يستطيع الدفاع عن العدالة السياسية؛ يمكنه مواجهة الإسلام العابر للحدود، لكنه لا يستطيع مساءلة السلطة الوطنية.
بهذا المعنى، لا تمثل عودة الأزهر اليوم انقلابًا على منطق الدولة العميقة، بل استمرارًا له بصيغة جديدة. فالدولة المصرية، كما في مراحل سابقة، لا تختار بين الدين واللادين، بل بين أنماط مختلفة من التدين، وتعيد توزيع الأدوار بينها وفق اعتبارات الأمن والسيادة والاستقرار. وإذا كان الإخوان قد استُبعدوا لأنهم نافسوا الدولة سياسيًا، وإذا كانت السلفية قد حُجّمت حين فقدت وظيفتها، فإن الأزهر يُعاد توظيفه اليوم بوصفه الأداة الأكثر ملاءمة لإنتاج دين وطني مضبوط، يحفظ النظام أكثر مما يفتح أفقًا نقديًا جديدًا.
في هذا السياق البنيوي تحديدًا جاء التدخل السعودي. فالسعودية لم تُنشئ السلفية المصرية من العدم، بل دخلت على مسار قائم، ووفّرت له موارد مالية ورمزية في لحظة تاريخية مناسبة. منذ السبعينيات، ومع الطفرة النفطية وصعود المملكة بوصفها مركزًا سنّيًا عالميًا، ومع انهيار المشروع القومي العربي بعد هزيمة 1967، أصبح الخطاب الديني المحافظ بديلًا رمزيًا عن الأيديولوجيات القومية المهزومة. الدعم السعودي لم يكن عشوائيًا ولا موجّهًا لكل ما هو “سلفي”، بل كان انتقائيًا بوضوح، يفضّل التيارات التي ترفض الثورة وتجرّم العصيان وتُعلي من شأن الطاعة والاستقرار، وهي القيم نفسها التي كانت الدولة المصرية في أمسّ الحاجة إلى تكريسها.
هكذا تلاقت مصلحتان: مصلحة دولة عميقة تسعى إلى ضبط المجتمع دون تسييسه، ومصلحة إقليمية سعودية تخشى الإسلام السياسي الثوري وتفضّل إسلامًا محافظًا منزوع السياسة. هذا التلاقي لم يُنتج تحالفًا رسميًا، بل نوعًا من التناغم الصامت الذي سمح للسلفية بأن تتحول، تدريجيًا، من تيار دعوي محدود إلى منظومة معيارية شاملة تحدد شكل اللباس، وأنماط السلوك، والعلاقات الاجتماعية، وتعريف “الصحيح” و”المنحرف” دينيًا وأخلاقيًا.
ومع هذا التحول، أدّت السلفية وظيفة سياسية غير مباشرة لكنها عميقة الأثر. فقد جرى نقل الصراع من المجال العام إلى المجال الأخلاقي، ومن سؤال “من يحكم؟” إلى سؤال “من هو المسلم الصحيح؟”. وبدل النقاش حول الفقر والسلطة والفساد، انشغل المجتمع بقضايا البدعة والشرك والحلال والحرام. هذه الإزاحة لم تكن مؤامرة واعية بالضرورة، لكنها كانت نتيجة منطقية لبنية خطاب يُعيد تعريف الأزمة بوصفها عقدية لا سياسية.
غير أن هذا التوازن لم يكن قابلًا للاستمرار إلى ما لا نهاية. ثورة 2011 كسرت القاعدة التي قامت عليها السلفية نفسها. حين فُتح المجال السياسي فجأة، وجدت السلفية نفسها مضطرة إلى اتخاذ موقف، فدخلت السياسة من الباب الذي طالما حرّمته. هذا الدخول لم يكن علامة نضج، بل كشف عن تناقض داخلي عميق بين خطاب يرفض السياسة وممارسة سياسية براغماتية، وبين ادعاء النقاء العقدي والتحالفات الظرفية. ومع عودة النظام السلطوي بعد 2013، لم تعد الدولة بحاجة إلى هذا الدور، فتم تحجيم السلفية كما حُجّم غيرها، وإن بطرق مختلفة.
في المحصلة، لا يمكن فهم السلفية في مصر بوصفها خصم الدولة أو بديلها، بل بوصفها أحد نتاجات إدارتها الطويلة للحقل الديني. لقد نشأت في الفراغ الذي صنعته الدولة، وترعرعت تحت رقابتها الصامتة، واستُثمرت إقليميًا حين خدمت الاستقرار، ثم جرى احتواؤها حين تغيّرت المعادلة. إن السلفية، بهذا المعنى، ليست مجرد تيار ديني، بل مرآة لبنية السلطة نفسها، تكشف كيف يمكن للخطاب “اللاسياسي” أن يصبح أحد أكثر أدوات السياسة فاعلية حين يُترك ليعيد تشكيل المجتمع من الداخل