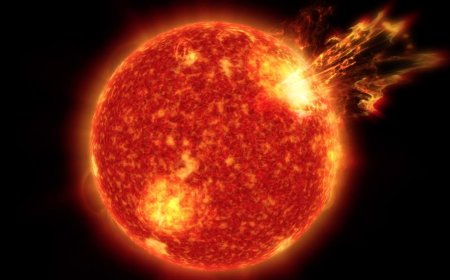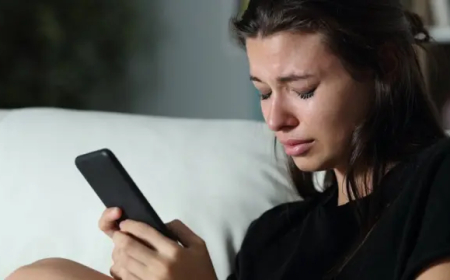الصهيونية تحت مجهر نقد ديني يهودي

باسم الموسوي
ليس من السهل أن يخرج نقد جذري للدولة «اليهودية» من داخل التقليد الديني نفسه، ولا أن يأتي التشكيك في شرعية القداسة السياسية على يد مفكّر متديّن صارم، لا علماني ولا ليبرالي. غير أن يشعياهو لايبويتس فعل ذلك بلا تردّد، وبلا مواربة، حين حوّل اليهودية من هوية قومية قابلة للتوظيف السياسي إلى عبء أخلاقي ولاهوتي ثقيل على الدولة، وحين نزَع عن الأرض، والدولة، والأمة أي قداسة، ليعيدها حصرًا إلى الله وحده.
كتاب «اليهودية، القيم الإنسانية، والدولة اليهودية» لا يمكن قراءته بوصفه نقدًا إصلاحيًا للصهيونية، ولا دفاعًا عن «يهودية أخلاقية» متصالحة مع الدولة، بل هو تفكيك جذري لفكرة الجمع بين الدين والسيادة السياسية. في هذا الكتاب، لا يقف لايبويتس عند حدود الاعتراض على سياسات بعينها، بل يطعن في البنية الفكرية التي تجعل من الدولة موضوعًا دينيًا، ومن الدين أداة شرعنة للسلطة.
ينطلق لايبويتس من تعريف صادم في بساطته وقسوته: اليهودية ليست عقيدة لاهوتية، ولا تجربة روحية، ولا منظومة قيم إنسانية عامة، بل هي ممارسة تعبّدية منظَّمة تُسمّى الهالاخاه. الإيمان، وفق هذا التصور، لا يُقاس بما نعتقده عن الله، بل بما نفعله أمامه. لا معرفة ميتافيزيقية، ولا وعود خلاصية، ولا رسالة أخلاقية كونية، بل طاعة عملية تُمارَس «لذاتها» لا لغرض آخر.
بهذا التعريف، ينسف لايبويتس محاولتين متقابلتين ظاهريًا لكن متشابهتين في الجوهر: الأولى صهيونية علمانية ترى في الدين مجرد تراث تاريخي أدّى دوره وانتهى، والثانية دينية–قومية ترى في الدولة تجسيدًا لإرادة إلهية أو مقدّمة للخلاص. كلاهما، في نظره، يستخدم الدين خارج معناه الديني، أي يُفرغه من طابعه التعبّدي ليحوّله إلى أيديولوجيا.
يتغذّى هذا التصور من تقاطع فريد بين مايمونيدس وكانط. فالله، عند لايبويتس، متعالٍ على المعرفة البشرية، لا يُدرَك بالعقل ولا بالتجربة. المعرفة مجالها العالم الطبيعي وحده، أما الإيمان فمجاله القرار. لا يوجد برهان على الإيمان، ولا حُجّة عقلية تُلزم به. من يؤمن، يؤمن لأنه قرر أن يطيع، لا لأنه «عرف».
هذه النقطة أساسية لفهم راديكالية لايبويتس. فالدين لا يمكن تبريره أخلاقيًا، ولا سياسيًا، ولا تاريخيًا. كل محاولة لتبريره بنتائجه – كأن نقول إن الدين «يحافظ على المجتمع» أو «ينتج قيَمًا سامية» – هي، في نظره، علمنة مقنّعة للدين. العبادة التي تحتاج إلى تبرير نفعي لم تعد عبادة.
من هنا ينتقل لايبويتس إلى نقد القومية، سواء كانت علمانية أو دينية. العداء هنا ليس للأمة بوصفها واقعًا اجتماعيًا، بل لتحويلها إلى قيمة مطلقة. حين تصبح «بقاء الأمة» أو «قوة الدولة» أو «وحدة الشعب» غاية عليا، يُستدعى الدين لتكريسها، وتتحول القومية إلى وثنية حديثة.
الدولة، في هذا الإطار، ليست سوى جهاز إدارة مصالح: أمن، جيش، ضرائب، سلطة. لا معنى دينيًا لها بذاتها. وكل محاولة لإضفاء قداسة عليها، سواء باسم التاريخ أو الوعد الإلهي أو المصير المشترك، ليست إلا تأليهًا للسياسة. الدولة التي تُقدَّس تُحصَّن ضد النقد، وتُعفى من المحاسبة، وتصبح قادرة على تبرير كل عنف باسم «الضرورة».
من أكثر أطروحات لايبويتس إثارة للجدل قوله إن «الأخلاق فئة لا دينية». لا يعني بذلك أن المتديّن لا يمكن أن يكون أخلاقيًا، بل إن الدافع هو ما يميّز الفعل. الفعل الأخلاقي يُنجز بدافع الواجب الإنساني، أما الفعل الديني فيُنجز بدافع العبادة. حين نطيع الله لأن ذلك «أخلاقي»، نكون قد جعلنا الأخلاق معيارًا أعلى من الله. وحين نتصرف أخلاقيًا لأن ذلك «أمر ديني»، نكون قد ألغينا استقلال الأخلاق.
هذه القسوة المفهومية تجعل لايبويتس خصمًا للخطابات التي تحاول تبرير سياسات ظالمة باسم «قيم دينية»، كما تجعله خصمًا أيضًا للخطابات الإنسانية التي تريد اختزال الدين في بعده الأخلاقي. في الحالتين، هناك خلط مدمّر بين مستويات مختلفة.
بلغ فكر لايبويتس السياسي ذروته بعد عام 1967. لم يتعامل مع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفه مسألة أمنية أو تفاوضية، بل بوصفه امتحانًا لجوهر اليهودية نفسها. الاحتلال، في نظره، لا يفسد السياسة فقط، بل يُفسد الدين، لأنه يدفع المتديّن إلى تقديس الأرض، والجيش، والدولة، بدل عبادة الله.
تحذيراته كانت مبكرة وحادّة: دولة تحكم شعبًا آخر بالقوة ستتحول بالضرورة إلى دولة بوليسية، وسيصبح جيشها أداة قمع، وسينحطّ وعيها الأخلاقي. الأخطر من ذلك أن الدين نفسه سيتحوّل إلى أيديولوجيا تبريرية، تُشرعن القتل والهيمنة باسم القداسة.
من هنا، لم يكن رفضه للاحتلال موقفًا «حقوقيًا» بالمعنى الليبرالي، بل موقفًا لاهوتيًا صارمًا: الدين الذي يحتاج إلى دبابة كي يستمر هو دين ساقط.
على خلاف الصورة الشائعة، لم يدعُ لايبويتس إلى فصل الدين عن الدولة دفاعًا عن الدولة المدنية، بل دفاعًا عن الدين نفسه. حين تصبح المؤسسة الدينية جزءًا من جهاز الدولة، تتحول إلى بيروقراطية، إلى شبكة مصالح، إلى شريك في السلطة. عندها تفقد قدرتها على النقد، وتتحول من شاهد أخلاقي إلى ذراع تبريرية.
الدولة، في تصوره، يجب أن تظل فضاءً للصراع السياسي المفتوح، لا مرجعية دينية نهائية. والدين، إذا أراد أن يبقى دينًا، يجب أن يقف في مواجهة السلطة لا في خدمتها.
لأنه يرفض كل التسويات المريحة. لا يمنح اليسار عزاء «الدين الأخلاقي»، ولا يمنح اليمين شرعية «الدولة المقدسة». يضع الدين في مواجهة السياسة، لا في خدمتها. ويذكّر بأن أخطر ما يصيب الأديان ليس الإلحاد، بل تحالفها مع السلطة.
في زمن تُستعاد فيه الهويات الدينية لتبرير الاحتلال والعنف والإقصاء، يبدو لايبويتس صوتًا نشازًا، لكنه ضروري. ليس لأنه يقدّم حلًا جاهزًا، بل لأنه يفضح الوهم: وهم أن الدولة يمكن أن تكون دينية من دون أن تفسد الدين، أو أن الدين يمكن أن يكون سياسيًا من دون أن يتحوّل إلى أيديولوجيا قمعية.