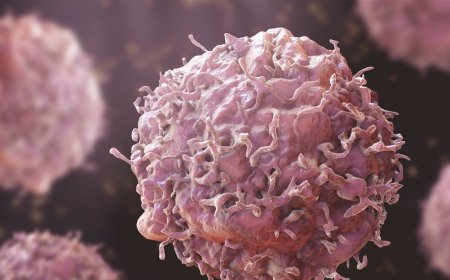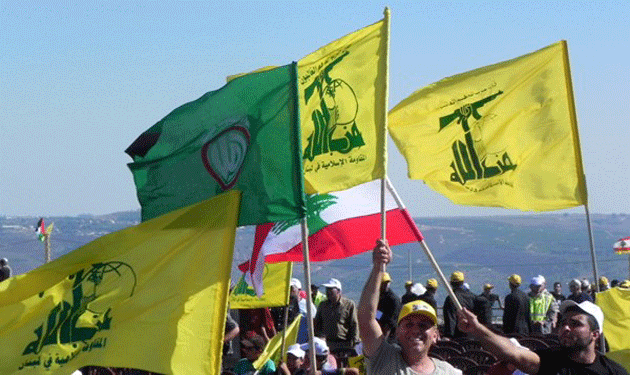أيُّ صوت نُدخله بيوتنا؟
مقال يتأمّل في معنى المحتوى الذي نستهلكه، والقيم التي نقود بها وعينا، من بيروت إلى العالم، حيث يتحوّل الخطاب إلى فعل، والكلمة إلى مسؤولية.

كتبت هناء بلال
لم يعد السؤال اليوم: ما المحتوى الأكثر انتشارًا؟
بل: أي محتوى يستحق أن يسكن وعينا؟
ففي زمن التدفق الهائل، لم يعد الخطر في غياب المعلومة، بل في غياب البوصلة التي تُرشدنا إلى ما نستهلكه، ونصدّقه، ونسمح له أن يتسلّل إلى وعينا الجمعي بهدوء.
نحن لا نبحث عن محتوى يُدهشنا لحظة ثم يتركنا أكثر فراغًا، ولا عن خطاب يراهن على الخوف أو الإثارة العابرة. ما نريده هو محتوى يبني الإنسان ولا يستثمر في هشاشته، محتوى يُخاطب العقل دون أن يُقصي القلب، ويوقظ الأسئلة بدل أن يوزّع إجابات جاهزة.
المحتوى الذي ننشده هو ذاك الذي ينطلق من التجربة الإنسانية الصادقة، لا من الادعاء ولا من التنظير المجرد. تجربة تُقال بصدق، ثم تُفكَّك، وتُقرأ، وتُعاد صياغتها لتصبح معرفة مشتركة، لا بطولة فردية. محتوى لا يُقدّم صاحبه بوصفه نموذجًا مكتملًا، بل إنسانًا في حالة تشكّل دائم.
في هذا الإطار، لا يمكن فصل الخطاب عن سياقه الاجتماعي والسياسي والثقافي. فحين أُطلقت جولة “الدنيا” الثانية من بيروت إلى الدنيا، لم تكن مجرد انتقال جغرافي من مدينة إلى أخرى، بل انتقال رمزي من المحلي إلى الإنساني الأوسع. جولة حاولت أن تفتح مساحات للحوار بين الغريب والسائد، وأن تطرح لقاءً مفتوحًا عن الحبّ والحياة، لا بوصفهما شعارات عاطفية، بل أسئلة وجودية تتقاطع عندها المدن العربية والعالم.
دلالة هذه الجولة لا تكمن فقط في مسارها، بل في الاعتراف الرسمي والمعنوي بنهجها، إذ باركت السيدة الأولى نعمت عون انطلاقتها باستقبالها في القصر الجمهوري للدكتور خالد غطاس ، مشددة على أهمية هذا المسار بوصفه دعوة لحماية بيوتنا، وعائلاتنا، وهويتنا، وبناء مجتمع يقوم على الخير، والنفع، والنور. هذا الاحتضان لا يمكن قراءته كحدث بروتوكولي فحسب، بل كإشارة إلى أن الخطاب القيمي، حين يُقدَّم بلغة معاصرة، يصبح جزءًا من النقاش العام لا هامشه.
في هذا السياق، يبرز خطاب غطاس كنموذج قابل للقراءة النقدية. فانتشاره الواسع لم يأتِ من فراغ، بل من اعتماده على السرد التجريبي بوصفه مدخلًا أساسيًا إلى وعي المتلقي. يبدأ من تجربة شخصية أو حالة قريبة من الناس، ثم يتوسّع نحو تجارب الآخرين، ليصوغ منها خلاصات أخلاقية واجتماعية تُقدَّم بلغة بسيطة، لكنها محمّلة بالرسائل.
خطابه يقوم على معادلة دقيقة: التوجيه عبر الحكاية لا عبر الوعظ. وهو ما يمنحه قدرة على التأثير النفسي، خصوصًا لدى جمهور يبحث عن المعنى وسط ضجيج المنصات الرقمية. غير أن هذه القدرة نفسها تفتح باب التساؤل النقدي:
هل يكفي صدق التجربة لتتحوّل إلى قاعدة عامة؟
وأين تنتهي القصة، وأين يبدأ التحليل؟
وهل القرب العاطفي من المتلقي يوسّع وعيه أم يحدّ من مسافته النقدية؟
القيم التي يطرحها هذا الخطاب من حماية الأسرة، إلى إعادة الاعتبار للعلاقات الإنسانية، والتحذير من التفكك الاجتماعي تتقاطع مع قلقٍ جماعي حقيقي. إلا أن المفارقة تكمن في أن هذا الخطاب، رغم نقده لسطوة العالم الرقمي، يستثمر أدواته بذكاء: الإيقاع، الاختزال، والحضور الشخصي. وهنا يبرز سؤال آخر:
هل نحن أمام مشروع فكري طويل الأمد، أم خطاب مرتبط بلحظة اجتماعية تحتاج إلى من يعبّر عنها؟
ما يُحسب لهذا النهج أنه حاول تجاوز الكلام إلى الفعل، عبر مبادرات توعوية شبابية تتضمن عمل فعلي مبني على القيم و الفكر و الفن، كان محورها الأساسي بناء الإنسان، لا بوصفه متلقيًا سلبيًا، بل فاعلًا في محيطه. غير أن القراءة النقدية تظل ضرورية لفحص قدرة هذه المبادرات على التحوّل من تجربة مؤثرة إلى نموذج مستدام، ومن خطاب إلهامي إلى رؤية تربوية واضحة المعالم.
نحن، حين نختار المحتوى الذي نتابعه، لا نبحث عن الأكثر صخبًا، بل عن الأكثر اتساقًا. لا عن من يملك الإجابة عن كل شيء، بل عن من يملك شجاعة السؤال، وربط المعرفة بالقيم، والفكرة بالسلوك، والكلمة بالفعل.
وفي عالم تتسارع فيه التحوّلات، يصبح المحتوى فعل مسؤولية، لا مجرد إنتاج. وتغدو متابعة صانع محتوى ما، شكلًا من أشكال الاختيار القيمي:
لمن نمنح وقتنا؟
ومن نسمح له أن يؤثّر في وعينا؟
وأي إنسان نريد أن نكون؟
ربما لا نغيّر العالم دفعة واحدة، لكننا نملك دائمًا حق الاختيار: أن ننحاز إلى محتوى يُرمّم الإنسان بدل أن يستهلكه، ويؤمن بأن حماية البيوت والهوية تبدأ أولًا من الكلمة الصادقة، ومن لقاءات تعيد للحبّ والحياة معناهما الإنساني الأعمق.