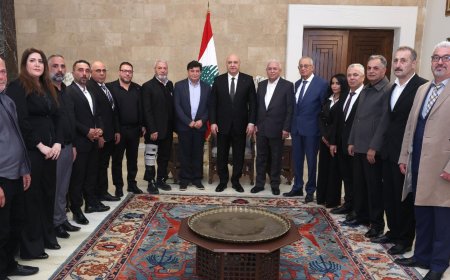هنري كوربان: عالم المثال، أو دفاعٌ أخير عن الغيب في وجه لاهوت المادّة

باسم الموسوي
لم يكن التعبير الذي صاغه هنري كوربان «اmundus imaginalis» بالمعنى النفسي أو التخييلي الحديث، بل كان مصطلحًا فلسفيًا–أنطولوجيًا دقيقًا: عالم المثال، ذلك العالم الأوسط القائم بين عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم لا يُدرك بالحس، ولا يُختزل بالعقل المفهومي، بل يُعاش بالرؤية، ويُنال بالخيال الفاعل، كما صاغته الفلسفة الفارسية الإشراقية، من السهروردي إلى التشيّع العرفاني. هذا التصحيح ليس تفصيلاً تقنيًا، بل هو المدخل الضروري لفهم كوربان في ذاته، لا كما قرأه خصومه أو مريديه السطحيون.
عالم المثال عند كوربان ليس خيالًا ذاتيًا، ولا منطقة رمزية معلّقة، بل مرتبة وجود حقيقية، هي التي تحفظ إمكان الوحي، والنبوة، والملَك، والمعاد، وتمنع اختزال الدين إلى أخلاق اجتماعية أو طقوس تاريخية. من دون هذا العالم الأوسط، ينهار البناء الديني كله، لأن الغيب يصبح مستحيل الحضور، والشهادة تصبح مكتفية بذاتها، ويُختزل الدين إلى ثقافة أو وظيفة اجتماعية.
من هنا، لا يمكن فهم كوربان بوصفه هاربًا من التاريخ فحسب، بل بوصفه مدافعًا عن الغيب بوصفه شرط الدين ذاته. وهو لم يُخفِ هذه الغاية، بل جاهر بها بوضوح لافت: لقد رأى نفسه ابنًا للبيت الذي استضافه، أي للحضارة الإسلامية–الإيرانية، في لحظة كان يشعر فيها أن هذا البيت مهدّد من الداخل والخارج، لا بالعلم وحده، بل بما سمّاه — ضمنًا وصراحة — لاهوت المادّة الآتي من التراث الإكويني الغربي، وقد تُرجم حداثيًا في صورة عقلانية مفرغة من الغيب.
في نظر كوربان، لم تكن العلمنة مجرد فصل بين الدين والدولة، بل تفريغًا ميتافيزيقيًا للعالم، قطع الصلة بين السماء والأرض، وحوّل الإنسان إلى كائن تاريخي صرف، بلا عمق أنطولوجي. ومن هنا جاء قراره المنهجي الحاسم: أن يُقرأ الدين كما يقدّمه المؤمنون به لأنفسهم، لا كما تشرّحه السوسيولوجيا، ولا كما تختزله البسيكولوجيا.
فالدين، في تصوّره، لا يمكن فهمه بأدوات تنفي منذ البداية إمكان الغيب. علم الاجتماع يرى في الدين انعكاسًا للبنية الطبقية أو للصراع الاجتماعي، وعلم النفس يراه إسقاطًا لاشعوريًا، أمّا كوربان فيعتبر أن هذه الأدوات — مهما بلغت من الدقة — تبتر الظاهرة الدينية من قوامها. فهي تشرح الوظيفة، لكنها تقتل المعنى؛ تفسّر السلوك، لكنها تنفي الحقيقة التي يعتقد المؤمن أنها تؤسّسه.
هنا يتبدّى كوربان بوصفه خصمًا جذريًا للمنهج الاختزالي، لا لأنه يرفض العلم، بل لأنه يرفض علمًا يضع مسبقًا حدودًا لما هو ممكن الوجود. فهو لا يسأل: ما الذي يفعله الدين في المجتمع؟ بل: ما الذي يقوله الدين عن الوجود؟ ولا يرى في الجماعة الدينية مجرد بناء اجتماعي، بل كيانًا يتأسس على اشتراك أفراده في عالم غيبي مشترك، لا يمكن عزله عن تجربتهم التاريخية من دون تدميرها.
غير أن هذا الدفاع الصلب عن الغيب، وعن عالم المثال، يضع كوربان في موضع إشكالي. فحين يُعطى العالم الأوسط هذه المركزية المطلقة، يصبح التاريخ عرضيًا، والسياسة ثانوية، والصراع الاجتماعي تشويشًا على الحقيقة الرؤيوية. إن الدين، وقد حُصِّن أنطولوجيًا، يصبح عصيًا على المساءلة التاريخية. لا لأنه زائف، بل لأنه مرفوع فوق المحاكمة الزمنية.
هنا يبدأ التوتر الذي التقطه كتاب Religion After Religion بدقة. فالدين الذي يُقرأ حصريًا من داخل لغته الغيبية، قد يفقد القدرة على نقد نفسه حين يتحوّل إلى سلطة، أو حين يتجسّد في مؤسسات. عالم المثال يحمي الغيب، لكنه قد يعطّل السؤال الأخلاقي حين يتلبّس الغيبُ العنفَ أو الهيمنة أو الإقصاء. فالمؤمن الذي يرى نفسه في صراع كوني بين النور والظلمة، قد لا يرى خصمه بوصفه إنسانًا تاريخيًا، بل بوصفه حجابًا أو ظلمة.
ومع ذلك، لا يجوز اختزال كوربان إلى هذه النتيجة وحدها. فهو لم يكن داعية سلطة، ولا منظّر دولة، ولا فقيه تشريع. كان، في جوهره، مفكّرًا يقاوم تحويل الدين إلى مادة خام للعلوم الحديثة. مشروعه هو صرخة فلسفية في وجه عالم لم يعد يحتمل الغيب، لا لأنه دُحض، بل لأنه أُقصي.
بهذا المعنى، فإن «الدين بعد الدين» عند كوربان ليس دينًا جديدًا، بل محاولة لإنقاذ إمكانية الدين في عالم فقد شروطه. دين لا يقوم على الشريعة ولا على المؤسسة، لكنه أيضًا لا يرضى أن يُختزل إلى ثقافة أو أخلاق إنسانية عامة. إنه دفاع أخير عن المعنى الغيبي بوصفه قلب التجربة الدينية، وعن عالم المثال بوصفه الجسر الوحيد الذي يربط الإنسان بما يتجاوز تاريخه من دون أن يُلغيه.
إن مأزق كوربان — وعظمته معًا — أنه أدرك مبكرًا أن الحداثة لا تقتل الدين مباشرة، بل تفرغه من عالمه. فاختار أن يحمي هذا العالم، ولو على حساب التاريخ. وهنا تحديدًا يكمن السؤال المفتوح الذي يتركه لنا: هل يمكن حماية الغيب من دون تعطيل السياسة؟ وهل يمكن لعالم المثال أن يبقى جسرًا، لا مهربًا؟
هذا السؤال، لا مشروع كوربان نفسه، هو ما يجعل قراءته اليوم ضرورة فلسفية لا ترفًا معرفيًا.
بين عالم المثال ونقد العقل الديني: كوربان في مواجهة أبو زيد وأركون
يمكن القول إن هنري كوربان ونصر حامد أبو زيد ومحمد أركون لم يختلفوا حول تفاصيل في قراءة النص الديني، بل اختلفوا حول سؤال الأصل: من أين يبدأ فهم الدين؟ من الغيب أم من التاريخ؟ من التجربة الإيمانية أم من الشروط المعرفية التي أنتجتها؟ ومن هذا السؤال الأول تتشعّب جميع الفوارق اللاحقة.
كوربان يبدأ من مسلّمة لا يقبل المساومة عليها: الدين ظاهرة لا تُفهم إلا إذا أُخذت على محملها الوجودي الكامل، أي بوصفها خطابًا غيبيًا يرى العالم من خلال عالم المثال، العالم الأوسط الذي يتوسّط الغيب والشهادة. من دون هذا العالم، تنهار النبوة، وتفقد الملائكة معناها، ويصبح الوحي مجرّد نص تاريخي قابل للتفكيك. لذلك رفض كوربان كل المناهج التي تبدأ من الخارج: السوسيولوجيا، علم النفس، التاريخانية الصلبة. لم يرفضها لأنها خاطئة تقنيًا، بل لأنها – في نظره – تنفي مسبقًا إمكان الحقيقة الغيبية، أي تنقض الدين من أساسه.
في المقابل، ينطلق نصر حامد أبو زيد من مسلّمة معاكسة تمامًا: الدين، كما يصلنا، نصٌّ داخل التاريخ، لا يمكن فهمه خارج شروط إنتاجه اللغوية والثقافية والسياسية. لا ينفي أبو زيد الغيب بوصفه اعتقادًا إيمانيًا، لكنه يصرّ على أن هذا الغيب لا يُقرأ علميًا إلا عبر وسائط بشرية. الوحي، في لحظة دخوله اللغة، صار نصًا، والنص يخضع لقوانين الدلالة، والتاريخ، والصراع الاجتماعي. هنا لا يعود السؤال: كيف نحمي الغيب؟ بل: كيف نمنع الغيب من التحوّل إلى سلطة قاهرة؟
أما محمد أركون، فيذهب أبعد من أبي زيد، لا في رفض الغيب، بل في تعليق قدسيته المعرفية. أركون لا يسأل كيف نفهم النص، بل لماذا مُنِع السؤال أصلًا؟ مشروعه ليس هرمنيوطيقا إيمانية ولا نقدًا داخليًا للنص، بل تفكيك للعقل الإسلامي بوصفه منظومة تاريخية أقصت أسئلة بعينها، وحرّمت مجالات كاملة من التفكير. الدين عند أركون ليس فقط نصًا، بل مؤسسة معرفية مارست الإقصاء، وراكمت «اللامفكَّر فيه»، وأنتجت مناطق محظورة داخل الفكر.
هنا يتجلّى التعارض الجذري. كوربان يرى أن المناهج النقدية الحديثة، كما عند أبي زيد وأركون، تقتل الدين باسم العقل. فهي تحوّل الوحي إلى وثيقة، والتجربة الروحية إلى مادة تحليل، والجماعة المؤمنة إلى بنية اجتماعية. وبهذا المعنى، يرى فيها امتدادًا للاهوت المادي الغربي الذي فرّغ العالم من السماء. أمّا أبو زيد وأركون، فيريان أن مشروع كوربان يحصّن الدين ضدّ النقد، ويحوّله إلى تجربة نخبوية لا تُساءل، ويعيد إنتاج سلطة رمزية أكثر خطورة من السلطة الفقهية، لأنها غير مرئية.
كوربان يقرأ الدين كما يقدّمه المؤمنون به لأنفسهم، ويعتبر هذا شرط الأمانة العلمية. أبو زيد يرى في هذا الخيار خطرًا منهجيًا: فالمؤمن لا يملك وعيًا بريئًا، بل وعيًا مشكَّلًا بالصراع والسلطة والتأويل. وأركون يرى أن هذا “الاحترام” للتجربة الإيمانية ليس سوى تواطؤ معرفي مع البنية التي تمنع التفكير الحر.
لكن المفارقة العميقة أن كل مشروع ينتج مأزقه الخاص. مشروع كوربان، بحمايته لعالم المثال، ينجح في إنقاذ الغيب، لكنه يعجز عن التعامل مع الدين حين يتحوّل إلى دولة أو عنف أو تشريع. الغيب عنده سامٍ إلى درجة أنه لا يعرف ماذا يفعل حين يتجسّد. في المقابل، مشروع أبي زيد ينجح في تحرير النص من احتكار السلطة، لكنه يترك المؤمن العادي أمام سؤال قاسٍ: ماذا يبقى من الدين إذا صار كله تاريخًا وتأويلاً؟ أما أركون، فيفتح أفقًا نقديًا غير مسبوق، لكنه يدفع الدين إلى موقع دفاع دائم، كأنه متّهم في قفص العقل الحديث.
هكذا لا يكون كوربان مجرد “ضد” أبي زيد وأركون، بل مرآة معاكسة لهما. الثلاثة يشتركون في رفض الفقه السلطوي والدogمائية المغلقة، لكنهم يختلفون جذريًا في تشخيص الخطر الأكبر. كوربان يرى الخطر في فقدان الغيب. أبو زيد يرى الخطر في تأليه النص. أركون يرى الخطر في تحريم السؤال نفسه.
وبين هذه المشاريع الثلاثة يتشكّل سؤالنا المعاصر:
هل يمكن دين بلا عالم مثال؟
وهل يمكن غيب بلا نقد؟
وهل يمكن عقل نقدي لا يتحوّل إلى سلطة جديدة؟
ربما لا تكمن أهمية هذه المقارنة في ترجيح مشروع على آخر، بل في إدراك أن الدين الحديث ممزّق بين ثلاثة مطالب متعارضة: الحفاظ على المعنى، وتحرير العقل، ومنع السلطة. كوربان اختار المعنى، أبو زيد اختار العقل، أركون اختار التفكيك. وما زلنا نحن نعيش في الفراغ الذي خلّفه عجز كل مشروع عن احتواء المطالب الثلاثة معًا