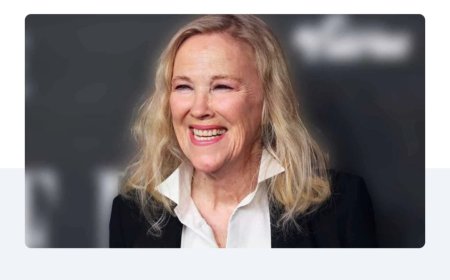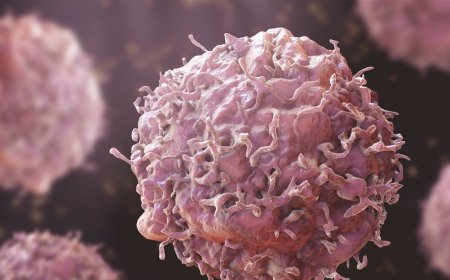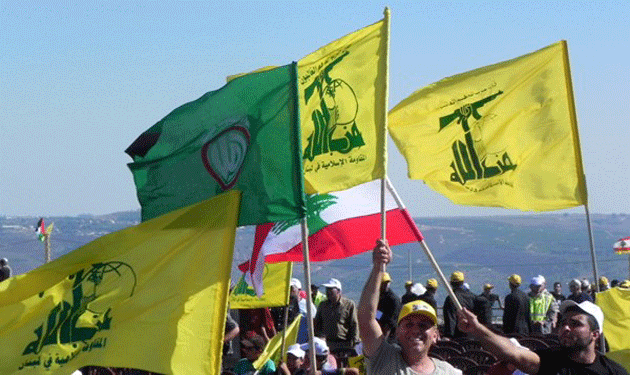لم ينتصر الغرب لأنه كان أذكى… بل لأن التاريخ كُتب بعد المدافع
قراءة نقدية معمّقة في سؤال «لماذا تقدّم الغرب وتأخر العرب؟» تفكك سرديات التفوق الغربي والاستشراق، وتعيد فهم التاريخ من منظور القوة والهيمنة لا التفوق الحضاري، مع مقاربة فكرية تربط النهضة العربية بسياقها السياسي والتاريخي العالمي.

كتب باسم الموسوي:
ما زال السؤال يلاحق وعينا العربي كما لو كان قدرًا فكريًا: لماذا تقدّم الغرب وتأخرنا نحن؟ ولماذا حكم العالم قرونًا طويلة، بينما انكفأنا إلى موقع التابع أو المفعول به؟ هذا السؤال، في صيغته الشائعة، ليس بريئًا، لأنه يفترض منذ البداية أن التفوق الغربي كان نتيجة طبيعية لتفوّق عقلي أو حضاري أو أخلاقي، وأن ما أصاب الشرق – والعالم العربي خصوصًا – لم يكن سوى عقوبة تاريخية على قصورٍ ذاتي أو عجزٍ بنيوي. غير أن العودة النقدية إلى تاريخ صعود الغرب، كما تكشفها الدراسات الحديثة غير الأوروبية، تُظهر أن هذا السؤال صيغ أصلًا داخل منطق الهيمنة، وأنه يعيد إنتاج الهزيمة بدل تفسيرها.
لم يكن الغرب، حتى أواخر العصور الوسطى، مركز العالم ولا مختبر التقدم. بل كان فضاءً طرفيًا فقيرًا، ممزقًا بالحروب، يعتمد في تجارته ومعرفته وتقنياته على الشرق الإسلامي والآسيوي. المدن الكبرى، شبكات التجارة، الصناعات المتقدمة، التنظيم المالي، والعلوم التطبيقية كانت مزدهرة في الصين والهند والعالم الإسلامي، من بغداد ودمشق والقاهرة إلى سمرقند ودلهي. ومع ذلك، أعاد الغرب لاحقًا كتابة هذا التاريخ من موقع المنتصر، فحوّل التفوق العسكري الطارئ إلى تفوق حضاري دائم، وجرّد الآخرين من أي مساهمة فاعلة في صنع العالم الحديث.
في السياق العربي-الإسلامي تحديدًا، لا يمكن فهم “التأخر” دون تفكيك هذه السردية. فالانحطاط لم يكن قانونًا داخليًا، كما تزعم الأدبيات الاستشراقية، بل نتيجة اصطدام تاريخي عنيف مع نظام عالمي جديد تشكّل بالقوة. الإمبراطورية العثمانية، التي تُقدَّم غالبًا كدليل على “الجمود الشرقي”، كانت في الواقع لاعبًا مركزيًا في النظام الدولي لقرون، وقد شكّلت توازنًا جيوسياسيًا حال دون توحيد أوروبا مبكرًا، ودفعها – paradoxically – إلى البحث عن طرق بحرية بديلة، أي إلى الاستعمار. بعبارة أخرى، لم تصعد أوروبا رغم الشرق، بل جزئيًا بسببه.
وحين بدأت الرأسمالية الأوروبية في التشكل، لم تولد من السوق الحر ولا من عبقرية اقتصادية ذاتية، بل من شبكة عالمية من العنف والنهب والعمل القسري. الهند، التي كانت إحدى أكثر مناطق العالم إنتاجًا وثروة، جرى تدمير صناعاتها عمدًا لصالح التصنيع البريطاني، والعالم العربي أُدرج تدريجيًا في الاقتصاد العالمي كمصدر للمواد الخام وممر تجاري ومجال نفوذ، لا كمركز إنتاج مستقل. هذه العملية لم تكن “تحديثًا”، بل تفكيكًا قسريًا للبنى الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
الأخطر من ذلك أن الغرب لم يكتفِ بالهيمنة، بل شرعنها معرفيًا. حوّل الفجوة التي أحدثها بالقوة إلى دليل على التفوق العقلي، وقرأ التاريخ بأثر رجعي: بما أنه انتصر، فلا بد أنه كان الأجدر. وبما أن الآخر هُزم، فلا بد أنه كان ناقصًا. هكذا جرى اختزال قرون من التاريخ العربي-الإسلامي في لحظة سقوط، وتحويل الانقطاع إلى هوية، والهزيمة إلى طبيعة ثابتة.
هذا المنطق لا يزال يعمل في وعينا المعاصر. فكل نقاش عربي حول النهضة يبدأ من سؤال “لماذا نحن متخلفون؟” بدل أن يسأل: كيف فُرض علينا موقع التخلّف؟ وكيف جرى تفكيك شروط الاستقلال التاريخي؟ ولماذا يُطلب منا دائمًا أن نلحق بنموذج صُنع أصلًا على حسابنا؟ إن خطورة هذه الأسئلة لا تكمن في بعدها الأكاديمي، بل في أثرها السياسي: فهي تنقل الصراع من مستوى القوة والهيمنة إلى مستوى الأخلاق والثقافة، وتجعل الضحية مسؤولة عن موقعها.
لكن النقد هنا لا يعني تبرئة الذات أو إنكار أزمات الداخل. بل يعني إعادة وضع هذه الأزمات في سياقها التاريخي الصحيح. فالاستبداد، والتفكك، والاقتصاد الريعي، والتبعية، ليست صفات ثقافية أصيلة، بل نتائج تاريخية لتداخل القهر الخارجي مع تحالفات داخلية. وحين يُفصل الداخل عن الخارج، يصبح النقد مجرد جلد للذات، لا مشروع تحرر.
إن استعادة التاريخ على هذا النحو ليست تمرينًا في الماضي، بل شرط لفهم الحاضر. فالعالم الذي نعيش فيه اليوم – بنظامه الدولي، وحدوده، واختلالاته – هو استمرار لتلك اللحظة التي تحوّل فيها العنف إلى نظام، والاستثناء إلى قاعدة، والتفوّق العسكري إلى حق في القيادة. وما لم يُفكَّك هذا الإرث معرفيًا، سيظل الغرب معيارًا، وسنظل نحن “حالة”.
الخلاصة أن الغرب لم ينتصر لأنه كان أذكى، ولا لأن الشرق كان عاجزًا، بل لأن التاريخ لا يُكتب من موقع العدالة، بل من موقع القوة. والمهمة الفكرية اليوم ليست تمجيد الشرق ولا شيطنة الغرب، بل كسر هذه المعادلة ذاتها، وإعادة السياسة إلى التاريخ، والتاريخ إلى الصراع، والمعرفة إلى موقعها كأداة تحرر لا تبرير. فقط عندها يمكن أن يصبح سؤال النهضة سؤالًا مفتوحًا، لا اعترافًا مسبقًا بالهزيمة